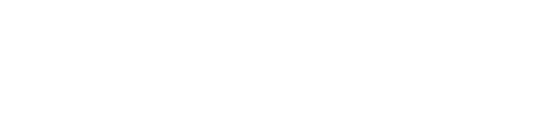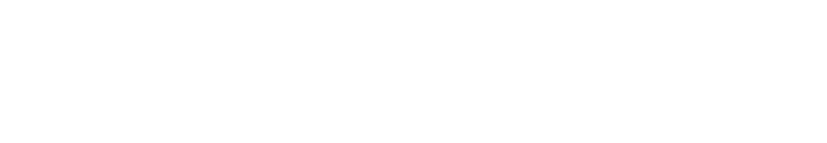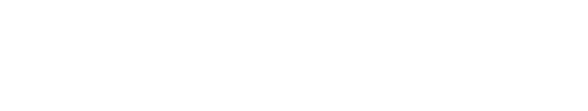|
قال سبحانه وتعالى في القرآن المجيد (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسانِ وَإِيتاءِ ذِي الْقُرْبى وَيَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ). [سورة النحل: الآية 90]. وقال عز من قائل: (فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون). [سورة الروم: الآية 9]. وفي آية أخرى: (ولقد أرسلنا رسلنا بالبيّنات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط). [سورة النساء: الآية 135]. وقوله عز وجل: (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط). [سورة النساء: الآية 135]. وفي موقع آخر قال الله العظيم: (وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين). [سورة الدخان: الآية 38]. وفي سورة الأنعام: (وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً لا مبدّل لكلماته). [سورة الأنعام: الآية 115]. وفي سورة النساء: (إن الله لا يظلم مثقال ذرة..). [سورة النساء: الآية 40]. وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (ما كرهته لنفسك فأكرهه لغيرك وما أحببته لنفسك فأحبّه لأخيك تكن عادلاً في حكمك، مقسطاً في عدلك، محباً في أهل السماء مودوداً في صدور أهل الأرض). وقال في حديث آخر (صلى الله عليه وآله): (إن العدل هو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا). وقال الإمام علي (عليه السلام): (العدل أساس به قوام العالم، العدل أقوى أساس، إن العدل ميزان الله الذي وضعه للخلق ونصبه لإقامة الحق فلا تخالفه في ميزانه ولا تعارضه في سلطانه)(1). والإمام علي في حواره مع عبد الله بن عباس حينما دخل عليه في ذي قار وعلي يخصف نعله، يروي ابن عباس قال لي: ما قيمة هذه النعل؟ فقلت لا قيمة لها فقال: (والله لهي أحبّ إليّ من إمرتكم إلا أن أقيم حقاً وأدفع باطلاً)(2). والإمام الصادق (عليه السلام) يقول: (أما العدل فإن لا تنسب إلى خالقك ما لامك عليه)(3). وفي احتجاج الطبرسي: روي أن قوماً من أصحاب أمير المؤمنين خاضوا في التعديل والتجويز فخرج حتى صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس إن الله تبارك وتعالى لما خلق خلقه أراد أن يكونوا على آداب رفيعة وأخلاق شريفة فعلم أنهم لم يكونوا كذلك إلا بأن يعرّفهم ما لهم وما عليهم والتعريف لا يكون إلا بالأمر والنهي والأمر والنهي لا يجتمعان إلا بالوعد والوعيد والوعد لا يكون إلا بالترغيب والوعيد لا يكون إلا بالترهيب، والترغيب لا يكون إلا بما تشتهيه أنفسهم وتلذّه أعينهم والترهيب لا يكون إلا بضد ذلك ثم خلقهم في داره وأراهم طرفاً من اللذات ليستدلوا على ما ورائهم من اللذات الخاصة التي لا يشوبها ألم ألا وهي الجنة وأراهم طرفاً من الآلام ليستدلوا به على ما ورائهم من الآلام الخاصة التي لا يشوبها لذة ألا وهي النار فمن أجل ذلك ترون نعيم الدنيا مخلوطاً بمحنها وسرورها ممزوجاً بكدرها وغمومها...). |
|
1 - ميزان الحكمة، ج6، ص86. 2 - نهج البلاغة، خطبة 33. 3 - الكافي، ج1، ص442. |
توطئة لا بد منها
كلما حاولت أن أفلت من زمام التاريخ الفكري لهذه المسألة ما استطعت وبالفعل ما استطعت أن أتجاوز ما دار في المدارس الفكرية الإسلامية من حديث ونقاش حول العدالة الإلهية فمرةً يشتد النقاش إلى درجة الخصام العقائدي ومرةً يفتر بانحناء واضح أمام العاصفة من أحد الأطراف المتنازعة وكان الصراع أشده بين المدرسة العدلية (المعتزلة) وبين مدرسة الأشاعرة وفي خضم هذا الصراع المرير كانت تبرز مدرسة أهل البيت (عليهم السلام) حاسمة للصراع والخلاف ضمن الأسلوب الدقيق الذي يوافق القرآن الكريم والسنة الشريفة من جهة ويوافق العقل والتطلعات الإنسانية من جهة أخرى.. على العموم أجد نفسي مضطراً لتناول المسألة تاريخياً لعل هذا سيفتح لنا آفاق المعرفة ويسهل علينا فهم المراد وهذا يتطلب شيئاً من التوضيح، ونحن إذ ندخل في جزءٍ حساس من عقيدتنا الإسلامية دراسةً وتحليلاً ولعلّ (العدل) من أشد المواضيع العقائدية حساسيّةً بين المسلمين وأكثرها إثارةً للمشاعر والخلفيات الثقافية والاجتماعية حيث أن مسألة العدل ملتصقة بحياة الناس وتوفيقهم في الحياة ووعيهم وعقيدتهم ومصيرهم في المستقبل بالدنيا والآخرة. فمن هنا تكسب قضية العدل الإلهي أهمية بارزة في حياة المسلمين الفكرية. ومن هنا نفهم أهميتها وحساسيتها التي دفعت بالمسلمين للمناقشات وكثرة الجدل في كافة أدوار التاريخ الإسلامي حتى اليوم وعلى أسس فهم العدالة الإلهية نشأت مدارس فكرية بين المسلمين، ففي منتصف القرن الأول الهجري نضجت البحوث الكلامية وعلى رأسها العدل ومما لا شك فيه أن الإسلام يؤمن بالحرية الفكرية بل يدفع القرآن الكريم الناس للتفكير والتدبر والاعتبار فيثير دفائن العقول لتنطق الفطرة الإنسانية النقية متلاقحةً مع أسس الدين الإسلامي فقد قال سبحانه: (أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها). [سورة محمد: الآية 24]. والرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) كذلك يدفع بالتفكير الإيجابي فقد قال: (فكرة ساعة خير من عبادة سنة) ويقول الإمام علي (عليه السلام): (التفكر يدعو إلى البر والعمل به)(4). وهذه الحرية الفكرية تفتح على الإنسان آفاق الخير والصلاح وترسخ العقيدة في الأعماق. وهكذا فالإسلام يعالج كثيراً من المسائل الفكرية والنفسية والغيبية بالتفكير الذاتي والمناقشة الفكرية. هذه الحالة أفرزت عدة تساؤلات من كوامن اللاشعور لدى الإنسان المسلم آنذاك وخصوصاً بعد هبوب الرياح الفكرية القديمة والاغريقية مترجمةً إلى العربية على الأفكار الإسلامية ويمكن القول باجتماع الأسباب واشتراكها بنسب معينة في تهيئة المناخ الفكري المحتدم الصراع فيما بين المسلمين ولا تنكر العقليات الإسلامية المتّقدة التي تصدت لبلورة الموقف الإسلامي لكثرة الاثارات والتساؤلات في ذات المجتمع المسلم فبرزت مسألة الجبر والاختيار والقضاء والقدر والمسائل الفلسفية الأخرى التي تصبّ مجتمعةً في موضوع العدالة الإلهية التي هي من أبرز صفاته جلّ وعلا. لذلك نشأت مدارس فكرية الواحدة أمام الأخرى وبالذات مدرسة المعتزلة التي وقفت أمام مدرسة الأشاعرة في مجمل المسائل الفكرية ويحتدم الصراع الفكري في قضية العدالة أشد احتدام فظهرت المجبرة أمام المفوضة فالإنسان المجبر على أفعاله بدون إرادة مستقلة هل من العدل أن يعاقب أو يكافأ على أعماله بنوعيها الأعمال الإيجابية أو السلبية؟ أما الإنسان المختار في أعماله أمن العدل محاسبته أم لا؟ وهكذا برزت المدرسة الوسطى هي مدرسة أهل البيت (عليهم السلام) - كما قلنا - لتحسم هذا الصراع لصالح المبدأ الرسالي المستقيم الذي كان بدوره هذا يتوج الفطرة الإنسانية الطبيعية بتعاليم الله عز وجل ومع هذا فقد امتازت مدرستا المعتزلة والأشاعرة بنقاط قوة إيجابية ونقاط ضعف سلبية وكل مدرسة عرفت نقاط الضعف ونقاط القوة في المدرسة الفكرية المقابلة وشعرت كذلك بنقاط ضعفها وقوتها فبرزت ودافعت وبرّرت لضعفها فنجحت حيناً وأخفقت أحياناً كثيرة في الدفاع لمغالطات فكرية واضحة تصطدم بها في النتائج المترتبة على مقدمات مغلوطة أيضا ولم تقف المسألة عند هذا الحد بل انسحبت من أطر المفكرين والعلماء إلى ساحة المجتمع وفي باب (لا تقوى في الصراع) نزلت القضية لعموم الناس فصار التسقيط والتكفير بين الطرفين علامة مميزة لحقبة زمنية من العصر الإسلامي بل وانسحب الأمر مع الزمن كذلك مما وفّر مناخاً مناسباً لظهور اللعب السياسية وللاستفادة من هذا الصراع لتقوية كراسي الحكام في أدوار سياسة مختلفة. فمدرسة المعتزلة كانت تؤمن بفكرة العدل الإلهي في مسألة الجبر والاختيار أما مدرسة الأشاعرة فإنها تؤمن بفكرة المشيئة الإلهية (ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن) وقدمت مدرسة الأشاعرة تفسيراً للمسألة حيث رأت أن ما يفعل سبحانه وتعالى في الكون والمخلوقات هو فعل حسن وخير محض وعدل. وهكذا فالذي ورد في الشريعة ممدوحاً فهو الحسن والخير وفاعله يستحق الثواب والذي ورد في الشريعة مذموماً فهو القبيح وفاعله يستحق الذم والعقاب (فالمعني بالحسن ما ورد الشرع بالثناء عليه والمراد بالقبيح ما ورد الشرع بذم فاعله) كما جاء في (الإرشاد) للجويني، ص258، و(نهاية الأقدام) للشهرستاني، ص370. أما بالنسبة لأفعال الله عز وجل فكلها أفعال حسنة كما تذهب مدرسة الأشاعرة وليس للعدل قوانين ثابتة يسير عليها سبحانه بل كل ما يفعله هو العدل والخير والحسن حتى لو كان في تصورات البشرية وفي مفهومنا البشري أنه عقاب وعذاب فهو حسن وعدل لأنه صادر من الله عز وجل (إن الله هو المالك القاهر الذي ليس بمملوك وليس فوقه آمر ولا زاجر ولا من رسم له الحدود، لذلك لا يقبح منه فعل شيء نراه قبيحاً...)(5) فكل شيءٍ عندهم عدلٌ لمجرد إسناده إلى الله تعالى وكل شيء حسن لأنه من الله تبارك وتعالى. فقد قال سبحانه: (فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون). [سورة الروم: الآية 9]. وفي آية أخرى: (وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين). [سورة الدخان: الآية 38]. وقد قال الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله): (إن العدل هو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا). أما المعتزلة فادّعوا أن العدل له معيار خاص تسير عليه الأفعال والتصرفات فاعتقدوا أن العدل أساس لقانون الله سبحانه فمكافأته للمؤمنين بالجنة والرضا عدل ومعاقبته للمجرمين بالنار والسخط والأذى عدل فقد قال عز وجل: (وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار...). [سورة البقرة: الآية 25]. وقال في آية أخرى - بالمقابل -: (وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون). [سورة النحل، الآية 118]. وقال سبحانه أيضا: (وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون). [سورة الأعراف، الآية 165]. ومن هنا تنطلق مسألة الحسن والقبح فالمعتزلة يذهبون إلى أنها مسألة عقلية بحتة والعقل يستطيع أن يصل إلى أن الكذب قبيح والصدق حسن والظلم قبيح والعدل حسن ولا يحتاج الأمر لتوضيح شرعي يعني أن العقل المجرد عن التعاليم الشرعية بإمكانه الوصول إلى معرفة الحسن والقبح في الأقوال والأعمال أما الأشاعرة فهم على عكس المعتزلة حيث ذهبت مدرستهم إلى إنكار قدرة العقل في كشف النقاب عن الأفعال الحسنة والقبيحة بل لابد من تدخل الشريعة الإسلامية في تبيان الحسن من الأفعال وفرزه عن قبيح الأعمال - كما مر آنفاً - فبهذا المعنى - لدى الطرفين المتنازعين - انعكس الأمر على الخالق الكريم فذهبت مدرسة المعتزلة إلى أن الله سبحانه لديه غايات وأهداف من الخلق، والأفعال الصادرة عنه فهو الحكيم المدبر. أما الأشاعرة فرفضت رأي المعتزلة ووقفت مدرستهم بالمقابل لمدرسة المعتزلة متذرعة بأن المسألة تجرنا إلى الخروج من العقيدة الإسلامية الصحيحة حيث نفرض على الله أغراضاً معينة ليسير لتحقيقها وهذا منافٍ لأصول التوحيد ولعلاقة الرب مع المربوب فرفضت مدرسة الأشاعرة مسألة الأغراض والأهداف في أفعال الله معللة ذلك إن فعل الله عين الصواب والحكمة والمصلحة دون أن نفرض بعقولنا المحدودة طريق الحكمة والمصلحة والهدف الحسن والحكيم مسبقاً وتتضح هنا قمة الحساسية في المسألة لأنها تنعكس على الأصل الأول والرئيس من أصول العقيدة الإسلامية وهو اصل التوحيد فقد قررنا أن الله سبحانه لا شريك له ولا تأخذه سنة ولا نوم ولم يكن له ولي، فنستشم من المعتزلة أنهم بكلامهم يريدون فرض خطة معينة أو قوانين معينة لأفعال البارئ عز وجل مما يسلبه تعالى حق الاختيار والحرية في الخلق والفاعلية والإبداع والتصرف وحاشا لله من هذا التقيد وهذا بالضبط ما يفهمه الأشاعرة لذلك ثارت ثائرتهم ووقفوا أمام المعتزلة بقوة وعارضوا فكرة الجبر في أفعال الله واعتبروا أن المعتزلة يجبرون الله على أفعاله وتصرفاته أي لا إرادة لله أمام قانون الإنسان الذي يراه عدلاً. وفي الحقيقة هذه نقطة الضعف الواضحة في مدرسة المعتزلة حيث أنها ما استطاعت أن تضع الإجابة الوافية لهذه الشبهة ولعلّ الألفاظ قد خانت مدرسة المعتزلة في تبيان الأمر فلذلك وقعت المعتزلة في فخ عميق من خلال هذه الزاوية المثيرة. ويمكن أن نفصل في هذه المسألة وغيرها في الصفحات القادمة في أثناء أحاديثنا. وأما نقطة الضعف - التي تبدو أنها غير مقصودة ولكنها مستنتجة أيضا - لدى مدرسة الأشاعرة والتي كشفتها مدرسة المعتزلة تتلخص في أن كلّ الأفعال مصدرها الله وما يفعله الله هو عدل ومصلحة وحكمة هذا شمول كبير لكل ما يصدر في الطبيعة والكون من الأفعال حتى المظالم فلذا لا يتورع - كما يظهر - من يعتقد بمدرسة الأشاعرة صدور العبث والظلم والقبح عنه سبحانه! وهذا أمر مستحيل وإنه سبحانه منزّه عن هذه النواقص وشيئاً فشيئاً نضطر إلى سحب العدالة من الله عملياً حيث ندخل في إطار الجبر والاضطرار فيكون الظلم والقبح في أفعاله تعالى فعليه من الممكن أن تنسب إلى أفعاله سبحانه الظلم والقبح والنقص وهذا ما يصطدم بأصل التوحيد وصفات الله - كما قلنا - فلذلك نلاحظ عبد الجبار المعتزلي الذي كان يرى الاختيار والقانون العادل الذي يسير عليه سبحانه حينما التقى بأبي إسحاق الاسفراييني فقال عبد الجبار: (سبحان من تنزه عن الفحشاء) فأجابه أبو إسحاق: (سبحان من لا يجري في ملكه إلا ما يشاء) وحقاً كان يفهم الواحد الآخر وهكذا فإن الأشاعرة ينسبون الظلم والفحشاء لله سبحانه كنتيجة طبيعية لمقدماتهم والمعتزلة كانوا يحدّدون إرادة الله بإرادة وقانون الإنسان. وأما مدرسة أهل البيت (عليهم السلام) فجاءت لتضع حداً وسطاً بين الإفراط والتفريط لتحسم الأمر بين عموم الاشكالات الواردة. فتارة كان يقف مذهب أهل البيت مع المعتزلة وتارة مع الأشاعرة في نقاط الاتفاق مع الشريعة الإسلامية فنرى مثلاً حينما يقف مذهب أهل البيت مع المعتزلة في مسألة الجبر والتفويض إنه يعطي مفاهيم تغاير مفاهيم المعتزلة أو لنقل مكملة ومصححة للمفاهيم التي ينادي بها المعتزلة وإن كانت مدرستهم تحسب على العدلية فلا يترك مذهب أهل البيت المسألة مفوضة ولا مختارة بل (أمر بين أمرين) وبهذا تنتهي اشكالات الطرفين لا يؤلّه الإنسان بسلب إرادة الله سبحانه وبتحديد صلاحياته وتصرفاته على ضوء القانون العدلي كما تذهب المعتزلة، ولا هو يقع في مطب عدم التنزيه للذات المقدسة من القبح والظلم كما وقع الأشاعرة في ذلك، ويمكن أن توضح المسألة في مثال آخر ففي مسألة صفات الله سبحانه فالأشاعرة وقعوا في إشكال كبير حيث عددوا القدماء إلى جانب الذات المقدسة من حيث لا يشعرون فاعتبروا الصفات قديمة وأزلية ومغايرة للذات المقدسة فبذلك أثبتوا أن الأزلية ليست فقط لله بل لكل صفاته وهي قديمة بقدمه فإنها أزلية لا مخلوقة ولا محتاجة لعلة أو سبب للإيجاد فبهذا تشترك الصفات مع ذات الله في القوم وبمعنى آخر تتعدد الآلهة! بينما المعتزلة تخلصوا من هذه الإشكالية فوحّدوا الصفات مع الذات فتمحوروا حول القديم الواحد وهو الله سبحانه ومع نجاح المعتزلة في هذا البيان لكنهم لم يجيدوا الإخراج الفني فبقيت حلقة مفقودة في سلسلة البيان هذا حيث وضح المعتزلة أن الذات الإلهية هي نائبة عن الصفات بينما حدّد مذهب أهل البيت (عليهم السلام) توحيد الصفات مع الذات بالإضافة إلى اعتبار الصفات عين الذات - كما مرّ في الفصل السابق -. اكتفي بهذه التوطئة التي اعتمدتها على المعلومات العامة من مطالعاتي للكتب المعيّنة واظن أن الصورة قد وضحت تأريخياً، وأشير إلى من يطلب التفصيل فليراجع كتاب العدل الإلهي للشهيد مطهري. فقد اعتمدته كمصدر أساسي في هذه التوطئة. 4 - كتاب الحياة للشيخ الحكيمي، ج1، ص48. 5 - نهاية الأقدام للشهرستاني، ص397.