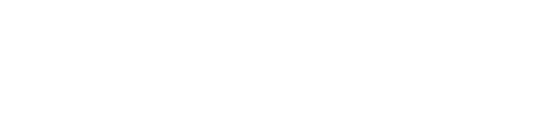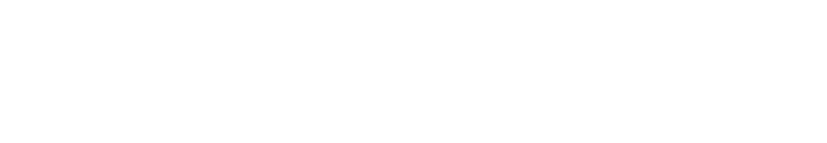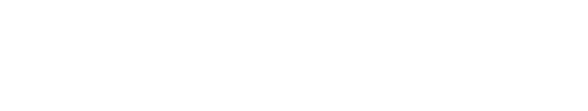إنّ لِدَعوة النبيّ الأكرم ـ صلَّى الله عليه وآله وسلم ـ خصائصَ أهمُّها أربعة أُمور، نذكرها في ثلاثة أُصول:
الأصلُ السابعُ والسبعون: عالمية دعوة النبي الأكرم ـ صلَّى الله عليه وآله وسلم ـ ورسالته
إنّ دعوةَ النبيّ الأكرم ونبوَّتَه ورسالَتهُ، عالميةٌ، ولا تختصُّ بقوم دون قوم، ومنطقة دون أُخرى. كما قال تعالى: ( وَما أرْسلْناكَ إلاّكاّفةً للنّاسِ بَشِيراً وَنَذِيْراً) ([1] ) .
ويقول أيضاً: ( وَما أرْسَلْناكَ إلاّ رَحْمَةً لِلعالَمِين) ([2] ) .
من هنا نرى كيفَ أنّه كانَ يستفيدُ في دعوته من لفظة (النّاس) وقال :
( يا أيُّها النّاسُ قَد جاءَكُمُ الرَّسُولُ بالحقّ مِن رَبّكُمْ فآمِنُوا خَيْراً لَكُمْ) ([3] ) . نعم عندما بدأَ النبيُّ الأكرمُ دعوَته كان طبيعيّاً أنْ ينذِرَ قومَه في المرحلةِ الأُولى، ويوجّه خِطابه إلى قومِهِ لينذرَ قوماً لم يُنذَرُوا مِن قَبل:
( لِتُنْذِرَ قوماً ما أتاهُمْ مِنْ نَذِير مِنْ قَبْلِكَ) ([4] ) .
ولكنَّ هذا لم يكن ليعني أنَّ مجالَ رسالته محدودٌ بجماعة خاصة، وإرشادِ قوم خاصّين.
ولهذا السبب نرى القرآنَ ـ أحياناً ـ في الوقت الذي يوجّه دعوته إلى جماعة خاصّة، يعمد فوراً إلى اعتبار دعوته تلك حجةً على كلّ الذين يمكن أن تبلغَهُمْ دعوتُه. إذ يقول: ( وَأُوحِيَ إليَّ هذا القرآنُ لأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ) ([5] ) .
إنّ مِنَ البديهيّ أنّ على الأَنبياء أنْ يَبدأوا أقوامَهم في البداية سواء أكانت دعوتهم عالميّة، أم محلِّية.
وهذا هو القرآنُ الكريم يُذَكّرُ بهذه الحقيقة:
( وَما أرْسَلْنا مِنْ رسَوِل إلاّ بِلِسانِ قَوْمِهِ لِيُبيّن لَهُمْ) ([6] ) .
الأصلُ الثامنُ والسبعون: إنّ نبي الإسلام ـ صلَّى الله عليه وآله وسلم ـ خاتم الأنبياء
إنّ نبوّة رسول الإسلام ـ صلَّى الله عليه وآله وسلم ـ نبوّةٌ خاتمةٌ، كما أنّ شريعته كذلك خاتمةُ الشرائع، وكتابهُ خاتمُ الكتب أيضاً.
يعني أنّه لا نبيَّ بعدَه، وأنّ شريعَتَه خالدةٌ، وباقيةٌ إلى يوم القيامة.
ونحنُ نستفيدُ من خاتميّة نبوّته أمرين:
1. إنّ الإسلام ناسخٌ لجميع الشرائعِ السابقة، فلا مكانَ لتلك الشرائعِ بعد مجي الشريعةِ الإسلاميةِ.
2. إنّه لا وجودَ لِشَريعة سماوية في المستقبل، وادّعاء أي شريعة بعد الشريعة الإسلامية أمرٌ مرفوضٌ.
إنّ مسألة الخاتميّة طُرحت ـ في القرآن والأحاديث الإسلامية ـ بشكل واضح، بحيث لا تترك مجالاً للشك لأحد.
وفيما يأتي نشيرُ إلى بعضها في هذا المجال :
( ما كانَ مُحمَّدٌ أبا أَحَد مِنْ رِجالِكُمْ وَلكِن رَسُولَ الله وَخاتمَ النَبِيّين وكان اللهُ بِكُلّ شَيء عَليْماً) ([7] ) .
والخاتَم هو ما يوضع في الإصبع من الحُليّ، وكان في عصر الرسالة يُخَتُم بفصّه على الرسائل، والمعاهدات، ليكونَ آيةً على انتهاءِ المكتوب. وفي ضوء هذا البيان يكون مفاد الآية هو أنّ كتابَ النبوّات والرسالات خُتِم بمجي رسول الإسلام فلا نبيَّ بعدَه، كما يُخَتمُ الكتاب بالخاتَم، فلا كلامَ بعدَه.
على أنّ لفظَ الرسالة حيث إنّه ينطوي على معنى إبلاغ أشياء (الرسالة) يتلّقاها النبي عن طريق الوحي (النبوة)، لهذا فإنّ من الطبيعي أنْ لا تكونَ الرسالة الإلهيّةُ من دون نبوّة، فيكون ختم النبوات ملازماً ـ في المآل ـ لختم الرسالات.
ثم إنّ في هذا المجال أحاديث وروايات متنوّعة، وعديدة، نكتفي بذكر واحد منها وهو حديثُ «المنزلة».
فعندما كان رسولُ الإسلام ـ صلَّى الله عليه وآله وسلم ـ ـ يريد أنّ ـ يتهيّأَ لغزوة تبوك، خلّف الإمامَ عليّاً ـ عليه السَّلام ـ في المدينة وقال له: «أما ترضى أنْ تكونَ منّي بِمَنزلةِ هارونَ مِن مُوسى إلاّ أنّه لا نبيَّ بَعدِي».
هذا وثمَّت مجموعةٌ من الأحاديث المتواترةِ إجمالاً ترتبط بالخاتميّة عدا حديث «المنزلة» المتواتر نُقِلَت ورُوِيت في الكتب.
الأصلُ التاسعُ والسبعون: كمال الدين الإسلامي
إن سرَّ خلودِ الشريعة الإسلامية يَكْمُنُ في أمرين :
ألف : إنّ الشَريعة الإسلامية تُقَدّمُ لضمان وتحقيق حاجة البَشَرِ الطبيعيّة والفطريّة، الى الهدايات الإلهيّة، أكمل برنامج عُرِف بحيث لا يمكن تصوّر ما هو أفضل وأكمل منه.
ب : بَيَّنَ الإسلامُ في مجال الأحكام العمليّة كذلك سلسلةً من الأُصول والكليّات الجامعة والثابتة التي يمكنها أن تلبّي الحاجاتِ البشريةِ المتجدّدةِ والمتنوعة أوّلاً بأوّل.
ويشهد بذلك أنّ فُقَهاء الإسلام (وبالأخص الشيعة منهم) قدروا طوال القرون الأربعة عشرة الماضية أنْ يلبُّوا كلّ إحتياجات المجتمعات الإسلامية على صَعيد الأحكام، ولم يَحْدُث إلى الآن أن عَجَزَ الفِقْهُ الإسلاميّ عنِ الإجابة على مُشكلة في هذا المجال.
هذا والأُمور التالية مفيدةٌ، ومؤثرةٌ في تحقيق هذه الغاية وهذا الهدف:
1 . حجيّة العقل:
إنّ اعتبار العقل، ومنحه الحجية، والقيمة المناسبة في المجالات التي يقدر فيها على الحكم والقضاء ، هو إحدى طرق استِنْباط وظائِفِ البشر في الحياة.
2 . رعايةُ الأهمّ عِند مُزاحمة المهمّ:
إنّ الأحكام الإسلاميّة ـ كما نعلَمُ ـ ناشئةٌ من طائفة من الملاكات الواقعيّة، والمصالح والمفاسد الذاتيّة (أو العارضة) في الأشياء، وهي ملاكاتٌ ربما أدرك العقلُ بعضها، وربما لم يدرِكِ البعضَ الآخر، وإنما بيَّنَها الشرعُ. وفي ضوء معرفةِ هذه الملاكات يستطيعُ الفَقِيهُ ـ بطبيعة الحال ـ أن يحلَّ المشكلة بتقديم الأهمّ على المهمّ، فيما إذا وقعَ تزاحمٌ بينهما .
3 . فتح باب الاجتهاد :
إن فتح باب الإجتهاد في وجه الأُمّة الإسلامية ـ الذي يُعتبر من مفاخر الشيعة وامتيازات التشيّع ـ هو الآخرَ من الأسباب الضامنة لخاتمِيّة الدين الإسلاميّ واستمراريّته، لأنّه في ظلّ الإجتهاد الحيّ والمستمرّ يمكن استنباط أحكام الموضُوعات، والحوادث الجديدة، باستمرار، من القواعد والضوابط الإسلامية الكليّة.
4 . الأَحكامُ الثّانَوِيّةُ :
هناك في الشريعة الإسلاميّة مضافاً إلى الأحكام الأوّليّة، طائفةٌ من الأحكام الثانوية التي تستطيع أن تحلَّ الكثيرَ من المشاكل.
فعلى سبيلِ المثال: عندما يصبَحُ تطبيقُ حكم من الأحكام الإسلامية على موضوع موجِباً للعُسر والحَرَج، أو مُستلزِماً للإضرار بأشخاص (بالشروط المذكورة في الفقه الإسلاميّ) هناك أُصولٌ وقواعدُ مثل قاعدة «نفي الحرج»، أو «نفي الضرر» تساعد الشريعة الإسلاميّة على فتح الطرق المسدودة وتجاوز المشاكل.
يقول القرآن الكريم: ( وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدِّينِ مِنْ حَرَج) ([8] ) .
وجاء في الأحاديثِ النَبَويّة: «لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ»([9] ). ولابَدّ مِنَ القَول ـ بكل يقين ـ بأنّ ديناً يَتحلّى بامتلاك هاتين القاعدتين ونظائرهما، لن يواجهَ أتباعُهُ قط طريقاً مسدوداً، في حياتهم، ومسيرتهم.
ومعالجةُ مَسألة الخاتميّة بشكل مسهب موكولةٌ إلى الكتب الإعتقادية.
الأصلُ الثمانون: السهولة والاعتدال من خصائص الشريعة الإسلامية
من خصائص الشَريعة الإسلاميّة «الإعتدالُ»، و «سهولة درك المفاهيم والأحكام الإسلامية»، وهو أمر يمكن أنْ يكون أَحدَ أهَمّ أسباب نفوذ هذا الدين وانتشاره بين شعوب العالم المختلفة.
إنّ الإسلام يعرض ـ في مجال معرفة الله ـ توحيداً خالصاً، وواضحاً، وبعيداً عن أيّ إيهام وتعقيد.
فسورة «التوحيد» التي هي من سُوَر القرآن القصار، يمكن أنْ تكون خير شاهد على هذا الأمر.
كما أنّ القرآنَ يُؤكّد في مجال مكانة الإنسان أيضاً على مَبدأ التَّقوى الّذي هو شاملٌ لجميع الخِصال الأَخلاقية، الرفيعة، والنبيلة.
وفي مجال الأحكام العملية نرى كذلك أنّ الإسلام يَنفي أيَّ عُسْر وحَرَج، وقد وَصَفَ النبيُّ نفسُهُ شريعتَهُ بالسهولة والسَّماحة فقال: «جِئْتُ بالشَرِيعةِ السَّهْلةِ السَّمْحَةِ». ورغم أنَّ بعضَ المستشرقين بسبب جهلهم أو عنادِهم يرون أنّ القوّة والسَيف كان هو السبب في انتشار الإسلام السريع، والعريض في العالم، فَإنّ المحقّقين المنصفين وغير المغرضين حتى من العلماء غير المسلمين يذعنُون ـ بكلّ صَراحة ـ أنَّ أهمَّ عامل لانتشار الإسلام السريع، هو وضوح التعاليم والأحكام الإسلامية وجامعيّتها. كما قال العالِمُ الفرنسي المعروف، الدُكتور «غوستاف لوبون» في هذا المجال: إنّ رمزَ تقدّم الإسلام يكمن في سُهُولته. إنّ الإسلام منزّه عن الأُمور التي يمتنعُ عن قبولها العقلُ السليم، والتي يوجَد نماذج كثيرة لها في الشرايع الأُخرى.
إنّنا مهما أمعنّا النظر وفكرنا فإنّنا لن نجد أبسط من أُصول الإسلامِ الذي يقول: اللهُ واحد، والناسُ أمامَ الله سواسية، والإنسانُ يحظى بالجنة والسعادة بالإِتيان بعدّة فرائض دينية، ويقع بالإعراض عنها في جهنم.
إنّ وضوح الإسلام وتعاليمه وبساطتها هذه ساعدت كثيراً على تقدّم هذا الدين في العالم.
والأهم من هذا، ذلك الإيمانُ الراسخُ الذي صَبَّه وأوجدَه في القلوب، إنّه إيمانٌ لا تقدر أيّةُ شُبْهة على اقتلاعه.
إنّ الإسلامَ كما انّه يكون أنسبَ من أيّ دين آخر، وأكثره ملائمةً مع المكتشفات العلمية. كذلك هو في مجال حمل الناس على العفو والصفح أكبر دين يستطيع أنّ يتولّى مهمة تهذيب النفوس والأخلاق([10] ).
الأصلُ الواحدُ والثمانون: صيانة القرآن من التحريف
إنّ الكتبَ السماويّة التي عَرَضَها الأنبياء السابقون تعَرضت ـ وللأسف ـ من بعدهم للتحريف بالتدريج بسبب الأغراض المريضة، وبسبب مواقف النفعيّين.
ويشهَد بذلك ـ مضافاً إلى إخبار القرآنِ الكريم بذلك ـ شواهدُ تاريخيّة قاطعةٌ.
كما أنّ مطالعة نفس تلك الكتب والتأمل في محتوياتها من المواضيع تدلُّ على ذلك أيضاً، فإنّ هناك طائفة من المواضيع في هذه الكتب لا يمكن أن يؤيّدها الوحيُ الإلهيّ.
هذا بغضّ النظر عن أنّ الإنجيل الحاضر يحتوي في أكثره على حياة السيّد المسيح ـ عليه السَّلام ـ ، وحتى صَلْبِهِ.
ولكن رغم وقوع التحريفات الواضحة في الكتب السماويّة السابقة، فإنّ القرآنَ الكريم بقي مصوناً من أيّ نوع من أنواع التحريف، والتغيير.
فإنّ رسول الله ـ صلَّى الله عليه وآله وسلم ـ ترك للبشرية من بعده (مائةً وأربع عَشَرة) سورة قرآنيّة، كاملة، وقد قام كُتّابُ الوَحي، وبالخُصوص الإمامُ عليٌّ ـ عليه السَّلام ـ بكتابة الوحي، وتدوينه منذ البداية.
وَلِحُسن الحظّ لم ينقص من القرآن الكريم، وسُوَره، وآياتِهِ شيءٌ قَطّ رغم مرور قرابة (15) قرناً على بدء نزول القرآن، كما لم يُزَد عليه شيءٌ أبداً. ونشير فيما يلي إلى بعض الأدلّة على عَدَم تحريف القرآنِ الكريم:
1. كيف يمكن أن يجدَ التحريفُ سبيلاً إلى القرآنِ الكريم، في حين أنّ الله تعالى تعهَّدَ صراحةً بحفظ القرآن، بنفسِهِ إذ قال: ( إنّا نَحْنُ نَزَّلنا الِذّكْرَ وَإنّا لَهُ لحافِظُونَ) ([11] ) .
2. إنّ الله تعالى نفى تطرُّق أيِّ نوع من أنواع الباطل إلى القرآن الكريم مهما يكن مصدرُهُ، نفياً قاطعاً فقال: ( لا يأتِيهِ الباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِن خَلْفِهِ تِنْزِيلٌ مِن حَكِيم حَمِيد) ([12] ) .
إنَّ الباطلَ الّذي يمكن أنْ يَتَطَرَّقَ إلى القرآن الكريمِ بصُوَرِهِ المختلفة، والذي قد نفاه الله تعالى نفياً قاطعاً، لا شكَّ هو الباطل الذي يوجب وَهْنَ القرآن الكريم، ويُضعِفُ مِن مكانتهِ ويَحُطُّ من مَنزلتِهِ، وحيث إنّ النَقْصَ من القُرآنِ الكريم، أو الزيادة في كلماته، وألفاظه مما يوهن مكانة القرآن قطعاً، ويقيناً، ويَحطُّ من شأنه، لهذا لا يوجد أيّ لون من ألوانِ الزيادةِ والنقص في القرآن الكريم أبَداً، ويقيناً.
3. إنّ التاريخ يشهدُ بأنَّ المسلمين كانوا يعتنون بالقرآن الكريم تعلّماً وتعليماً، قراءةً وحِفظاً أشدّ الاعتناء، وكان العرب في عصر النبيّ الأكرم ـ صلَّى الله عليه وآله وسلم ـ يتمتّعون بحافظة قويّة وذاكرة حادّة بحيث إذا سمعوا خطبةً أو قصيدةً طويلةً مرةً واحدةً حَفِظوها، وأتقنوها.
وعلى هذا كيف يمكن أن يُقال أنّ كتاباً مثل هذا، مع كثرة قارئيه، ووفرة حافظيه والمعتنين به، تعرّض للتحريف، أو الزيادة والنقصان؟!
4. لا شكَّ في أنّ الإمام أميرَ المؤمنين عليَّ بن أبي طالب ـ عليه السَّلام ـ كان يختلف مع الخلفاءِ، في بعض المسائل، وكان يُظهِرُ مخالفَتُهُ لهم في موارد مختلِفة بِصُورةِ منطقيّة، وتتمثل هذه الإعتراضات في الخطبة الشقشقيّة وبعض مناشداته على سبيل المثال.
ولكنّه لم يُسَمعْ ولا مرّةً واحدةً بأنّه ـ عليه السَّلام ـ تَحَدّثَ ـ ولا بِكلَمَة واحدة ـ عن تحريف القرآن الكريم، طيلة حياته.
فإذا كان هذا التحريف حدث ـ والعياذ بالله ـ لما سَكتَ عنه الإمامُ أميرُ المؤمنين ـ عليه السَّلام ـ ، بل ـ على العكس من ذلك ـ نجده ـ عليه السَّلام ـ يدعو إلى التأمُّل والتَدَبُّر في القرآنِ الكريمِ ومن ذلك قولهُ: «لَيْسَ لأَحد بَعْد القُرآنِ مِن فاقَة ولا بَعْدَ القرآنِ مِن غِنىً فكونوا من حَرَثَتِهِ وأتباعِهِ»([13] ).
وبالنظر إلى هذه الأدلة ونظائرها أكّدَ علماءُ الشيعة الإمامية واتّباعاً لأهل البيت ـ عليهم السَّلام ـ منذ أقدم العصور الإسلامية، على صيانة القرآن الكريم من التحريف نذكر منهم:
1. الفضل بن شاذان (المتوفّى 260 هـ ق) والذي كان يعيش في عصر الأئمة ـ عليهم السَّلام ـ ، وذلك في كتاب الإيضاح / 217.
2. الشيخ الصدوق (المتوفّى 381 هـ ق ) في كتاب الاعتقادات / 93.
3. الشيخ المفيد (المتوفّى 413 هـ ق) في كتاب أجوبـة المسائل السروّية، المطبوع ضمن مجموعة الرسائل / 266.
4. السيّد المرتضى (المتوفّى 436 هـ. ق) في كتاب: جواب المسائل الطرابلسيات الذي نقل الشيخ الطبرسي كلامه فيه، في مقدمة تفسيره: مجمع البيان.
5. الشيخ الطوسيّ المعروف بشيخ الطائفة (المتوفّى 460 هـ. ق ) في كتاب: التبيان1/3.
6. الشيخ الطبرسيّ (المتوفّى 548 هـ. ق) في مقدمة كتابه: «مجمع البيان»، حيث أكَّدَ فيها على عدم وقوع التحريف في القرآن الكريم.
7. السيد ابن طاووس (المتوفّى 664 هـ. ق) في كتاب: «سعد السعود/144» حيث يقول فيه: إن عدم التحريف هو رأي الإماميّة.
8 . العلامة الحِلّي (المتوفّى 726 هـ. ق) في كتاب: «أجوبة المسائل المهنّائية / 121» حيث يقول فيه: «الحقُّ أنّه لا تبديلَ ولا تأخير ولا تقديم فيه، وأنّه لم يُزَد فيه ولم يُنْقص، ونعوذ بالله تعالى من أن يُعتَقَدَ مثلُ ذلك، فإنّه يوجب التَطَرُّق (أي تطرّق الشَكّ والوَهْن) إلى معجزة الرَسُّول ـ عليه السَّلام ـ المنقولة بالتّواتر».
ونكتفي بهذا القدر من أسماء علماء الإمامية المنكرين للتحريف، ونؤكّد على أنّ هذا كان ولم يزل إعتقاد عُلَماء الامامية، ويتّضح ذلك من مراجعة ما كتبه ويقوله مراجع الشيعة في العصر الحاضر.
الأصلُ الثاني والثمانون: مناقشة الروايات الدالّة على تحريف القرآن وردّها
لقد وَرَدَت في كتب الحديث، والتفسير، رواياتٌ يدل بعضُها على وُقوع التحريف في القرآن الكريم، ولكن يجب أن ننتبه إلى النقاط التالية:
أوّلاً: أنّ أكثر هذه الروايات نُقِلَتْ بواسطة أفراد غير موثوق بهم وجاءت في كتب لا قيمة لها. مثل كتاب «القراءات» لأحمد بن محمد السياري (المتوفّى 286 هـ ق) الذي ضَعَّفَهُ علماءُ الرجال وضعَّفوا رواياته، واعتبروه فاسد المذهب([14] ) أو كتاب علي بن أحمد الكوفي (المتوفّى 352 هـ ق) الذي قال عنه علماء الرجال بأنّه صار غالياً في أُخريات حياته.([15] )
ثانياً: بعض هذه الروايات التي حُمِلَت على التحريف، لها جانبُ التفسير، أي أنّها تفسّر الآية، وتكون من قبيل تطبيق المفادِ الكليّ للآية على مصاديقه، أو أحد مصاديقه. غير أنّ البعضَ تصوّر أنّ ذلك التفسير والتطبيق هو جزءٌ مِن القرآن الكريم، وقد حُذِفَ، أو سقطَ من القرآن الكريم.
فمثلاً فُسرت لفظةُ «الصِراط المُستَقيِم» في سورة الحمد في الروايات بـ «صراط النبي وأهل بيته» ومن الواضح جدّاً أنّ مثل هذا التفسير هو نوع من أنواع التطبيق الكليّ على المصداق الأكمل([16] ). ولقد قَسَّمَ الإمامُ الخمينيّ(رحمه الله) الرواياتِ التي فُهِمَ منها وقوعُ التحريف في القرآن الكريم إلى ثلاثة أقسام:
ألف : الروايات الضَعيفةُ التي لا يمكن الإستفادة منها والأخذ بها أبداً.
ب : الروايات المختلَقَة التي تلوح عليها علائم الوضع والإختلاق.
ج : الروايات الصحيحة التي لو تأمَّلْنا فيها بدقّة لاتّضح أنّ المقصودَ منها ليس هو التحريف اللَفظيّ (أي الزيادة والنقصان اللفْظِيّ) بل هو تحريف حقائِقها ومفاهيمها.([17] )
ثالثاً : انّ الواجب على الذين يريدون التعرّف على المعتقد الواقعي لأتباع مذهب من المذاهب، أنْ يرجعوا إلى الكتب الاعتقاديّة والعِلمية لذلك المذهب، لا الكتب الحديثية (أي التي تضم الأحاديث والأخبار) التي يَهتَمُّ مؤلفها في الأغلب بجمع الأحاديث وتدوينها، تاركاً التحقيق فيها، والإستفادة منها للآخرين.
كما أنّه لا يكفي لمعرفة المعتقد الحقيقيّ والمسَلَّم لأي مذهَب من المذاهب، الرجوعُ إلى الآراء الشاذّة التي طَرَحَها أو يطرحُها أفرادٌ من أتباع ذلك المذهب.
وأساساً لا يمكن الإستناد إلى قولِ فرد أو فردين في مقابل رأي الأكثريّة القاطعة والساحقة من عُلَماء المذهب وجعله مِلاكاً صحيحاً للحُكمِ على ذلك المَذهَب.
وفي خاتمة البحث عن التحريف من الضَروريّ أنْ نُذَكّرَ بعدة نقاط هي:
1. إنّ اتّهام بعض المذاهب الإسلامية البعضَ الآخر بتحريف القرآن وخاصّة في العصر الحاضر لا يستفيد منهُ سوى أعداء الإسلام، وخصومه، ومناوئيه.
2. إذا أقدَمَ أحدُ علماء الإمامية بكتابة كتاب حولَ تحريف القرآن، وجب أن نعتبر ذلك رأيه الشخصيّ وليس رأيَ الأكثريّة الساحقة من علماء الإمامية.
ولهذا نرى أنّه أقدم علماءُ كثيرون من الإِمامية على كتابة ردود عديدة على ذلك الكتاب. تماماً كما حَدَثَ في أوساط أهل السنة حيث أقدم أحدُ علماء مصر على تأليف كتاب في تحريف القرآن باسم «الفرقان» عام 1345 هـ. ق، فَرَدَّ عليه علماءُ الأزهر، وأمَرُوا بمصادَرَتِهِ.
3. إنّ من العجيب جداً أن يحمل بَعْضُ المغرضين الذين أيسوا من الأساليب الأُخرى، كلّ هذه التصريحات القاطعة من قِبَل علماء الشيعة الإماميّة بعدم تحريف القرآن الكريم على «التقيّة»!! فإنّه يقال لهؤلاء بأنّ «التقية» ترتبط بأحوال شخص يكون في ظروف الخوف والخطر، وهؤلاء العلماء الكبار لم يكونوا يخافون أَحداً حتّى يضطرّوا إلى ممارسة «التقيّة».
ثم إنّ هذه الكتب قد ألّفها علماءُ الإمامية ـ في الأساس ـ لأتباع المذهب الشيعيّ، والهدف منها هو تعليم عقائد الشيعة لأتباع ذلك المذهب، ولهذا فإنّ من الطبيعي أنْ تحتوي هذه الكتُبُ على العَقائِدِ الحقيقية.
[1] . سبأ / 28 .
[2] . الأنبياء / 107 .
[3] . النساء / 170 .
[4] . السجدة / 3 .
[5] . الأنعام / 19 .
[6] . إبراهيم / 4 .
[7] . الأحزاب / 40. لا تنحصر الآياتُ الدالّة على خاتميّة رسول الإسلام في هذه، بل هناك سِت آيات قرآنية في هذا المجال تدلّ على خاتميته. راجع كتاب مفاهيم القرآن: 3 / 130 ـ 139 .
[8] . الحج / 78 .
[9] . وسائل الشيعة: 17، الباب 12 من إحياء الموات، الحديث 3.
[10] . حضارة العرب تأليف غوستاف لوبون .
[11] . الحجر / 9 .
[12] . فصلت / 42 .
[13] . نهج البلاغة، الخطبة 176 .
[14] . رجال النجاشي: 1 / 211 رقم الترجمة 190 .
[15] . رجال النجاشي: 1 / 96 رقم الترجمة 689 .
[16] . الطبرسي: مجمع البيان: 1 / 28.
[17] . تهذيب الأُصول: 2 / 96 .
[2] . الأنبياء / 107 .
[3] . النساء / 170 .
[4] . السجدة / 3 .
[5] . الأنعام / 19 .
[6] . إبراهيم / 4 .
[7] . الأحزاب / 40. لا تنحصر الآياتُ الدالّة على خاتميّة رسول الإسلام في هذه، بل هناك سِت آيات قرآنية في هذا المجال تدلّ على خاتميته. راجع كتاب مفاهيم القرآن: 3 / 130 ـ 139 .
[8] . الحج / 78 .
[9] . وسائل الشيعة: 17، الباب 12 من إحياء الموات، الحديث 3.
[10] . حضارة العرب تأليف غوستاف لوبون .
[11] . الحجر / 9 .
[12] . فصلت / 42 .
[13] . نهج البلاغة، الخطبة 176 .
[14] . رجال النجاشي: 1 / 211 رقم الترجمة 190 .
[15] . رجال النجاشي: 1 / 96 رقم الترجمة 689 .
[16] . الطبرسي: مجمع البيان: 1 / 28.
[17] . تهذيب الأُصول: 2 / 96 .