انقطاع الوحي
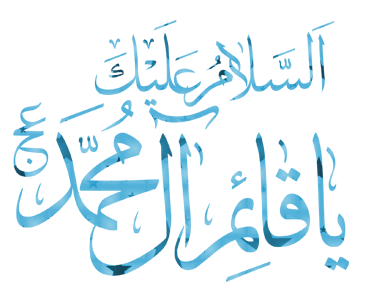
کان يوم رحيل الرسول الاعظم صلی الله عليه وآله وسلم أعظم فاجعةٍ مرّت على تاريخ البشريّة على الإطلاق، بمناسبة الفاجعة المزدوجة التي مثّل الجزءَ الأوّلَ منها انقطاعُ الوحي في تاريخ النوع البشري. هذه الظاهرة التي لم يعرف الإنسان في تاريخه الطويل الطويل ظاهرةً يمكن أن تماثلها أو أن تناظرها في القدسيّة والجلال والأثر في حياة الإنسان وتفكيره.
و يمثّل الجزءَ الآخرَ من الفاجعة هو الانحرافُ داخلَ المجتمع الإسلامي على يد المؤامرة التي قام بها [جناحٌ] من المسلمين بعد وفاة رسول الله (صلّى الله عليه وآله)، فانحرف بذلك الخطُّ عمّا كان مقرّراً له من قِبل النبي (صلّى الله عليه وآله) ، ومن قِبَل الله تعالى.
أحداث ما بعد الفاجعة:
كان هذا اليوم المشؤوم بدايةَ انحرافٍ طويل، ونهايةَ وحيٍ طويل، نهايةَ عهدٍ سعيدٍ بالوحي، تمثّل في مائةٍ وأربعةٍ وعشرين ألف نبي -كما في بعض الروايات(1)-، وكان بداية ظلامٍ ومحنٍ ومآسٍ وفواجع وكوارث من ناحيةٍ اُخرى، تمثّلت في ما أعقب وفاةَ النبي[ (صلّى الله عليه وآله)] من أحداث في تاريخ العالم الإسلامي، هذه الأحداث المرتبطة ارتباطاً شديداً قويّاً بما تمّ في هذا اليوم من الفاجعة، على ما في (الزيارة الجامعة) التي نقرؤها:
«[يَدْعُونَهُ إِلَى]بَيْعَتِهِمُ التي عَمَّ شُؤمُهَا الْإِسْلَامَ، وَزَرَعَتْ فِي قُلُوبِ أَهْلِهَا الْآثَامَ، وَعَقَّتْ سَلْمَانَهَا، وَطَرَدَتْ مِقْدَادَهَا، وَنَفَتْ جُنْدَبَهَا(2)، وَفَتَقَتْ بَطْنَ عَمَّارِهَا، وَحَرَّفَتِ الْقُرْآنَ، وَبَدَّلَتِ الْأَحْكَامَ، وَغَيَّرَتِ الْمَقَامَ، وَأَبَاحَتِ الْخُمُسَ لِلطُّلَقَاءِ، وَسَلَّطَتْ أَوْلَادَ اللُّعَنَاءِ عَلَى الْفُرُوجِ، وَخَلَطَتِ الْحَلَالَ بِالْحَرَام، وَاسْتَخَفَّتْ بِالْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ، وَهَدَمَتِ الْكَعْبَةَ، وَأَغَارَتْ عَلَى دَارِ الْهِجْرَةِ يَوْمَ الْحَرَّةِ، وَأَبْرَزَتْ بَنَاتِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ لِلنَّكَالِ وَالسُّوءَة(3) »(جاء النصُّ في المحاضرة الصوتيّة كالتالي: «بيعتهم التي عمّ شؤمها الإسلام، وزرعت في قلوب الاُمّة الآثام، وعنّفت سلمانها، وطردت مقدادها، ونَفَت جندبها، وفتقت بطن عمّارها، وأباحت الخمس للطلقاء وأولاد الطلقاء، وسلّطت اللعناء وأولاد اللعناء على المصطفَين الأخيار، وأبرزت بنات المهاجرين والأنصار إلى الذلّة والمهانة، وهدمت الكعبة، وأباحت المدينة، وخلطت الحلال بالحرام»،).(4)
إلى غير ذلك من الأوصاف التي نَعَتَ بها الإمامُ (عليه الصلاة والسلام)الجزءَ الثاني من الفاجعة الذي تمّ في هذا اليوم.
هذا الجزء الثاني من الفاجعة تحدّثنا عنه خلال الكلام عن حياة الأئمّة (عليهم الصلاة والسلام) ، وسوف نتحدّث عنه أيضاً خلال كلامنا عن مناسباتٍ اُخرى في حياة الأئمّة (عليهم الصلاة والسلام).
أودُّ الآن أن أقتصر على الجزء الأوّل من هذه الفاجعة، يعني أن أنظر إلى الحدث الواقع في هذا اليوم بوصفه حدثاً قد وضع حدّاً لتلك الظاهرة العظيمة التي اقترنت مع هبوط الإنسان على وجه الأرض، ظاهرة الوحي، ظاهرة ارتفاع الإنسان وتساميه للاتصال المباشر بالله سبحانه وتعالى.
ففي مثل هذا اليوم وُضِع حدٌّ نهائيٌّ لهذه الظاهرة المباركة الميمونة، وفي بعض الروايات: أنّ جبرائيل (عليه الصلاة والسلام) حينما ارتفع ملائكة السماء بروح محمّدٍ (صلّى الله عليه وآله) إلى ربّها راضيةً مرضيّةً، التفت إلى الأرض مودّعاً، ثمّ طار إلى سماواته(5).
هذا اليوم كان هو يوم انقطاع الإنسانيّة عن الاتصال المباشر بالله سبحانه وتعالى بانتهاء حياة خاتم الأنبياء والمرسلين (صلّى الله عليه وآله).
بهذه المناسبة اُريد أن اُعطي فكرةً موجزةً -على مستوى بحث اليوم- عن الوحي، هذا الوحي الذي انقطع في مثل هذا اليوم.
الوحي الذي يتمثّل في اتصالٍ خاصٍّ بين الإنسان وبين الله، هذا الوحي هو ضرورةٌ من ضرورات تخليد الإنسان على وجه الأرض. وبهذا خَلَقَ الله سبحانه وتعالى الإنسان، وأودعه الاستعداد الكامن، والأرضيّة الصالحة بإفاضة هذه الموهبة من الله سبحانه وتعالى ضمن شرائط وظروف موضوعيّة وذاتيّة معيّنة.
الحسُّ وأثره في تربية الإنسان:
وهنا أنا اُريد أن أدرس جانباً واحداً من ضرورة الوحي؛ لأنّ ضرورة الوحي يمكن أن توضع باعتبار جانبين في الإنسان. الآن أقتصر على أحد الجانبين.
الإنسان خُلق حسّيّاً أكثر منه عقليّاً، خُلق يتفاعل مع حسّه أكثر ممّا يتفاعل مع عقله، يعني: إنّ النظريّات والمفاهيم العقليّة العامّة في إطارها النظري، هذه المفاهيم، حتّى لو آمن بها الإنسان إيماناً عقليّاً، حتّى لو دخلت إلى ذهنه دخولاً نظريّاً، مع هذا: لا تهزّه، ولا تحرّكه، ولا تبنيه، ولا تزعزع ما كان فيه، ولا تنشئه من جديد إلّا في حدود ضيّقة جدّاً.
على عكس الحسّ؛ فإنّ الإنسان الذي يواجه حسّاً ينفعل بهذا الحسّ، وينجذب إليه، وينعكس هذا الحسّ على روحه ومشاعره وانفعالاته وعواطفه، بدرجةٍ لا يمكن أن يقايَس بها انعكاسُ النظريّة العقليّة، والمفهوم المجرّد عن أيّ تطبيقٍ حسّي.
وليس من الصدفة أنْ كان الإنسانُ على طول الخطّ في تاريخ المعرفة البشريّة أكثر ارتباطاً بمحسوساته من معقولاته، وأكثر تمسّكاً بمسموعاته وإبصاراته من نظريّاته؛ فإنّ هذا هو طبيعة التكوين الفكري والمعرفي عند الإنسان.
وليس من الصدفة أنْ قُرِنَ إثباتُ أيِّ دين -حقّانيّة أيّ دينٍ- بالمعجزة، وكانت أكثر المعاجز هي معاجز على مستوى الحسّ، أكثر معاجز الأنبياء كانت معاجز على مستوى الحسّ؛ لأنّ الإنسان يتأثّر بهذا المستوى أكثر ممّا يتأثّر بأيّ مستوىً آخر.
إذاً، فالإنسان -بحسب طبيعة جهازه المعرفي وتكوينه النظري- خُلق حسيّاً أكثر منه عقليّاً، خُلق متفاعلاً مع هذا المستوى المنخفض من المعرفة أكثر ممّا هو متفاعل مع المستوى النظري المجرّد من المعرفة، وهذا يعني أنّ الحسّ أقدرُ على تربية الإنسان من النظر العقلي المجرّد.
لو ترقّى الإنسان إلى نظره العقلي المجرّد وإلى حسّه المجرّد -يعني إلى ما يتّفق له من حسّ، وما يتّفق له من نظر- فسوف يسيطر الحسُّ عليه أكثر ممّا يسيطر عليه النظر، سوف يهيمن عليه حسّه ويحتلُّ من جوانب وجوده وشخصيّته وأبعاد مشاعره وعواطفه وانفعالاته أكثر ممّا يحتلّ العقلُ، المفهومُ النظريُّ المجرّد.
الحسّ هو المربّي الدرجة الاُولى لإنسانٍ هذا مزاجُه وهذا وضعُه. والعقل هو المربّي الدرجة الثانية لإنسانٍ هذا وضعه وهذا مزاجه.
بناءً على هذا، كان لا بدّ للإنسانيّة من حسٍّ مُربٍّ زائداً على العقل والمدركات العقليّة الغائمة الغامضة، التي تدخل إلى ذهن الإنسان في قوالب غير محدّدة وغير واضحة، ومكتنفة بدرجة كبيرة من الغموض والضباب.. إضافةً إلى هذه القوالب، كان لا بدّ لكي يربّى الإنسان على أهداف السماء، على مجموعةٍ من القيم والمُثُل والاعتبارات، كان لا بدّ من أن يكون له مربٍّ حسّي، كان لا بدّ من أن يربّى على أساس الحسّ، وهذا هو السبب في أنّ أيّ إنسانٍ وأيَّ حضارةٍ وأيّ مَدَنيّةٍ انقطعت عن السماء لم يربِّها العقل، بل ربّاها الحسّ.
نحن لا نعرف حضارةً انقطعت عن السماء ثمّ ربّاها العقل، بل كلّ الحضارات التي عرفها تاريخ النوع البشري إلى يومنا هذا، إلى حضارة الإنسان الاُوروبي اليوم التي تحكم العالم ظلماً وعدواناً، كلُّ هذه الحضارات التي انقطعت عن السماء ربّاها الحسُّ ولم يربّها العقل؛ لأنّ الحسّ هو المربّي الأوّل دائماً.
فكان لا بدّ لكي يمكن تربية الإنسان على أساس الحسّ-لكن على أساس حسٍّ يبعث في هذا الإنسان إنسانيّته الكاملة، الممثّلة لكلّ جوانب وجوده الحقيقيّة-، كان لا بدّ من خلق حسٍّ في الإنسان، هذا الحسّ يدرك تلك القيم والمثل والمفاهيم، يدرك التضحية في سبيل تلك القيم والمثل إدراكاً حسّيّاً، لا إدراكاً عقلانيّاً بقانون الحسن والقبح العقليّين فقط، بل يدركها كما ندرك محسوساتنا، مسموعاتنا ومبصراتنا.
وهذا معنى ما قلناه من أنّ ضرورة الإنسانيّة، ضرورة الإنسان في خطّ التربية، تفرض أن يودَعَ في طبيعة تكوينِه وخلقِه أرضيّة، هذه الأرضيّة صالحةٌ لأنْ تكوِّنَ مِثْلَ هذا الحسّ، لأنْ تكوّن حسّاً بحسن العدل، بقبح الظلم، بآلام المظلومين، أنْ تكوّن حسّاً بكلّ ما يمكن للعقل وما لا يمكن للعقل إدراكُه من قيمٍ ومثلٍ واعتبارات.
وهذه الأرضيّة أو هذا الاستعداد الكامنالذي كان لا بدّ من خلقه في طبيعة الإنسان، هذا الاستعداد هو استعداد الوحي، هو استعداد الارتباط المباشر بالله سبحانه وتعالى؛ لكي تنكشف كلُّ السحب، كلّ الستائر، عن كلّ القيم وكلّ المثل وكلّ هذه الاعتبارات والأهداف العظيمة، لكي تُرى رؤية العين وتُسمع سماع الاُذن، لكي يلمَسَها بيده، يراها بعينه، يشمّها، يتذوّقها.
كان لا بدّ من أن توجد هذه البذرة -بذرةُ مثل هذا الحسّ- في النوع البشري، إلّا أنّ وجدان هذه البذرة في النوع البشري لا يعني أنّ كلَّ إنسانٍ سوف يصبح له مثل هذا الحسّ، سوف يتفتّق إدراكه عن مثل هذا الحسّ، وإنّما يعني أنّ الإمكانيّة الذاتيّة موجودة فيه، إلّا أنّ هذه الإمكانيّة لن تخرج إلى مرحلة الفعليّة إلّا ضمن شروطها وظروفها وملابساتها الخاصّة، كأيّ إمكانيّةٍ اُخرى في الإنسان.
هناك شهواتٌ وغرائزُ موجودةٌ في الإنسان منذ يُخلق وهو طفل، ولكنّه لا يعيش تلك الشهوات ولا يعيش تلك الغرائز إلى مراحل متعاقبةٍ من حياته، فإذا مرّ بمراحل متعاقبة من حياته تفتّحت تلك البذور، وحينئذٍ أصبح يعيش فعليّةَ تلك الشهوات والغرائز.
هذا على مستوى تلك الشهوات والغرائز.
كذلك على مستوى هذا الحسّ، الذي هو أشرف وأعظم وأروع ما اُودع في طبيعة الإنسان.. هذا قد لا يعيشه مئاتُ الملايين من البشر في عشرات الآلاف من السنين، قد لا يتفتّح، يبقى مجرّد استعدادٍ خام وأرضيّة ذاتيّة تمثّل الإمكان الذاتي لهذه الطينة فقط، دون أن تتفتّح عن وجود مثل هذا الحسّ؛ لأنّ تفتُّحَه يخضع لما قلناه من الملابسات والشروط التي لها بحث آخر أوسع من كلامنا اليوم.
مراتب الحسّ:
هذه الأرضيّة، أرضيّة أن يحسَّ الإنسان بتلك القيم والمُثُل، هذه الأرضيّة تصبح أمراً واقعاً في أشخاص معيّنين يختصّهم الله تبارك وتعالى بعنايته ولطفه واختياره، وهؤلاء هم الأنبياء، وهم المرسَلون، الذين يرتفعون إلى مستوى أنْ تصبح المعقولاتُ الكاملةُ محسوساتٍ لديهم، يصبح كلُّ ما نفهمه وما لا نفهمه عقليّاً من القيم والمثل، يصبح أمراً حسّيّاً لديهم، يحسّونه ويسمعونه ويبصرونه؛ ذلك أنّ الأفكار التي ترد إلى ذهن الإنسان:
تارةً ترد إلى ذهن الإنسان وهو لا يدرك إدراكاً حسّيّاً مصدر هذه الأفكار.
واُخرى ترد إلى ذهن الإنسان وهو يدرك إدراكاً حسّيّاً مصدر هذه الأفكار.
الأفكار التي ترد إلى الإنسان كلّنا نؤمن بأنّها أفكار وردت إلى ذهن الإنسان وإلى فكره بقدرة الله وعنايته، لكنْ إيماننا بذلك إيمانٌ عقلي، نظري، لا أنّنا نحسّ هذا، وإنّما نؤمن به إيماناً نظريّاً عقليّاً، بأنّ الله تعالى هو مصدر العلم والمعرفة والأفكار الخيّرة في ذهن الإنسان. ولهذا: أيّ فكرةٍ من هذا القبيل تطرأ في ذهن إنسانٍ نؤمنُ عقليّاً بأنّها من الله تعالى.
لكنْ هناك فارقٌ كبيرٌ بين حالتين:
1- بين حالةِ أنْ تَرِدَ فكرةٌ إلى ذهن إنسان، فيحسّ هذا الإنسان بأنّ هذه الفكرة اُلقيت إليه من أعلى، بحيث يدرك إلقاءها من أعلى كما تدرك أنت الآن أنّ الحجر وقع من أعلى، أنّ قطرة المطر وقعت من أعلى، يدرك هذا بكلّ حسّه، وبكلّ سمعه وبصره، يدرك أنّ هذه القطرة، هذا الفيض، هذا الإشعاع، هو وقع عليه من أعلى، اُلقي عليه من قبل الله تعالى.
2- واُخرى لا يدرك هذا على مستوى الحسّ، يدركه عقليّاً، لكن لا يدركه حسّيّاً، يدرك أنّ هناك فكرةً تعيش في ذهنه، نيّرة، خيّرة، لكنّه لم يرَ بعينيه، لم يرَ أنّ هناك يداً قذفت بهذه الفكرة إلى ذهنه.
القسم الثاني [هو] الأفكار الاعتياديّة، الأفكار الاعتياديّة التي تعيش في أذهان الناس هي من القسم الثاني.
وأمّا القسم الأوّل -وهي الأفكار التي تُقذف في ذهن إنسان، فيتوفّر لدى ذاك الإنسان حسٌّ بها بأنّها قُذفت إليه من الله تعالى، واُفيضت عليه من واهب المعرفة- فهذه أيضاً على أقسام؛ لأنّ هذا الإنسان:
ألف- تارةً قد بلغ حسُّه إلى القمّة، قد استطاع أن يحسّ بالعطاء الإلهي من كلّ وجوهه، من كلّ جوانبه، يسمعه ويبصره، يراه من جميع جهاته، يتفاعل معه بكلّ ما يمكن للحسّ أن يتفاعل مع حقيقة.
هذا هو الذي يعبّر عنه بمصطلح الروايات - على ما يظهر من بعضها(6) - بمقامٍ عالٍ من الأنبياء، مقام الرسول الذي يسمع الصوت ويرى الشخص أيضاً.
ويمكن أن نفترض أنّ هناك ألواناً اُخرى من الحسّ تدعم هذا الحسّ السمعي والبصري عند هذا الإنسان العظيم؛ فهو يحسّ بالحقيقة المعطاة من الله تعالى من جميع جوانبها، يحسّ بها بكلّ ما اُوتي من أدوات الحسّ بالنسبة إليه.
هذا هو الدرجة العالية من الحسّ وقابليّة الاتّصال مع العطاء الإلهي.
ب - واُخرى يُفترض أنّه يحسّ بها من بعض جوانبها، وهو الذي عُبِّر
عنه بأنّه يسمع الصوت ولا يرى الشخص، هذا إحساس، إلّا أنّه إحساس ناقص.
ج - وقد يفترض أنّه أقلّ من ذلك، وهو الذي عبّر عنه في بعض الروايات بأنّه يرى الرؤيا في المنام.
هنا يرى شيئاً، هذه الرؤيا المناميّة طبعاً تختلف عن الرؤيا في اليقظة من حيث درجة الوضوح؛ فهنا فارقٌ كيفيٌّ بين الحسّ في الرؤيا المناميّة و[بين] الرؤيا في عالم اليقظة والانتباه الكامل.
هناك درجاتٌ من الحسّ، على وفق هذه الدرجات وضعت مصطلحات (الرسول) و(النبي) و(المحدَّث) و(الإمام) ونحوُ ذلك من المصطلحات، إلّا أنّ الذي يمثّل أعلى هذه الدرجات هو الوحي المتمثّل في مَلَكٍ يتفاعل معه النبي تفاعلاً حسّيّاً من جميع جوانبه، كما كان يعيش سيّد المرسلين (صلّى الله عليه وآله) مع جبرائيل (عليه الصلاة والسلام).
هنا: رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يعيش الحقيقة الإلهيّة عيشاً حسّيّاً من جميع جوانبها، يعيشها كما نعيش نحن على مستوى حسّنا وجودَ رفيقنا وصديقنا، لكنْ مع فارقٍ بين هذين الحسّين بدرجة الفارق بين المحسوسَيْن.
الحسّ هو الذي يربّي النبي:
هذا الحسّ هو الذي استطاع أن يربّي شخصَ النبي، بهذا الحسّ رُبّي شخصُ النبي، اُعدّ شخصُ النبي لكي يكون الممثّلَ الأوّلَ والرائدَ الأوّلَ لخطّ هذه القيم والمُثُل والأهداف الكبيرة.
يعني: هذا الحسّ قام بدور التربية للنبي؛ لأنّه استنزل القيم والمُثُل والأهداف والاعتبارات العظيمة، استنزلها من مستواها الغائم المبهم، من مستواها الغامض العقلي، من مستوى النظريّات العموميّة، أعطاها معالمَ الحسّ التي لا ينفعل الإنسان بقدر ما ينفعل بها.
فبهذا تصبح هذه الصورة المحسوسة التي هبطت على النبي، على أيّ نبيٍّ من الأنبياء، تصبح هذه الصورة ملءَ وجوده، ملء روحه، ملء كيانه، تصبح همَّه الشاغل له، ليله، نهاره؛ لأنّها هي أمامه، هو يراها، هو يحسّها، هو يلمسها ويشمّها أروع ممّا نلمس ونشمّ ونسمع ونبصر.
النبي هو الحسّ المربّي للآخرين:
ثمّ هذا الشخص الذي استطاع أن يربّيَه الحسُّ القائم على الوحي يصبح هو حسّاً مربّياً للآخرين؛ فالآخرون من أبناء البشريّة الذين لم تُتِح لهم ظروفهم وملابساتهم وعناية الله أن يرتفعوا هم إلى مستوى هذا الحسّ، الذين لم يُتَح لهم هذا الشرف العظيم، سوف يُتاح لهم الحسّ، لكن بالشكل غير المباشر، حسٌّ بالحسّ، لا حسّ بالحقيقة الإلهيّة مباشرة، حسٌّ بالمرآة، الحقيقة الإلهيّة -أقصد من الحقيقة الإلهيّة، يعني: المُعطى الإلهي، الثقافة الإلهيّة- الثقافة الإلهيّة انعكست على هذه المرآة، والآخرون يحسّون بهذه المرآة، بينما النبي نفسه كان يحسُّ مباشرةً بتلك الثقافة الإلهيّة بما هي أمرٌ حسّي، لا بما هي أمرٌ نظري.
أمّا نحن، نحسُّ محمّداً (صلّى الله عليه وآله) بما هو رجلٌ عظيم، بما هو رجل استطاع أن يثبت للبشريّة أنّ هناك اعتباراً وهدفاً فوق كلِّ المصالح والاعتبارات، فوق كلِّ الأنانيّات، فوق كلِّ الأمجاد المزيّفة والكرامات المحدودة، أنّ هناك إنساناً لا تنفد طاقته إذا ربط طاقته بطاقة الله، أنّ هناك إنساناً لا ينقطع نَفَسُه إذا كان دائماً يسير على خطّ رسالة الله تعالى(7).
هذا المضمون الذي بالإمكان أن ندركه عقليّاً، هذا المضمون الذي حشد فيه أرسطو وأفلاطون مئاتِ الكتب للبرهنة العقليّة على هذا، على إمكانيّة الاستمداد اللامتناهي من اللامتناهي(8)، هذا المعنى أصبح لدى البشريّة أمراً محسوساً، خرج من نطاق أوراق أرسطو وأفلاطون التي لم تستطع أن تصنع شيئاً، ولم تستطع أن تفتح قلب إنسانٍ على الصلة بهذا اللامتناهي، خرج من مستوى هذه الأوراق وأصبح أمراً حسّيّاً يعيش بين الناس، يعيش في قلوب الناس، يعيش مع تاريخ الناس؛ لكي يكون هذا الأمر المحسوس هو التعبير القوي دائماً عن تلك القيم والمُثُل، وهو المربّي للبشريّة على أساس تلك القيم والمُثُل.
فالوحي -بحسب الحقيقة إذاً- هو المربّي الأوّل للبشريّة، الذي لم يكن بالإمكان للبشريّة أن تربّى بدونه؛ لأنّ البشريّة بدون الوحي ليس لديها إلّا حسٌّ بالمادة وما على المادة من ماديّات، إلّا إدراكٌ عقليٌّ غائمٌ قد يصل إلى مستوى الإيمان بالقيم والمُثُل وبالله، إلّا أنّه إيمانٌ عقليٌّ على أيِّ حال، لا يهزّ قلب هذا الإنسان ولا يدخل إلى ضميره، ولا يصنع كلّ وجوده، ولا يتفاعل مع كلّ مشاعره وعواطفه.
فكان لا بدّ من أن يُستَنزل ذاك العقل على مستوى الحسّ، لا بدّ أن تُستَنزل تلك المعقولات على مستوى الحسّ، وحيث إنّ هذا ليس بالإمكان أن يعمل مع كلّ الناس؛ لأنّه ليس كلّ إنسان مهيّأً لهذا، ولهذا اختصّ بهذه العمليّة اُناسٌ معيّنون أوجد الله تبارك وتعالى فيهم الحسَّ القائدَ الرائد، هذا الحسّ ربّاهم هم أوّلاً وبالذات، ثمّ خلق حسّاً ثانويّاً، وجوداً حسيّاً ثانويّاً، هذا الوجود الحسّي الثانوي كان هو المربّي للبشريّة.
استنزال القيم العقليّة إلى مستوى المحسوسات:
أظنُّ أنّ الوقت انتهى، أنا أيضاً تعبت، لكن على أيّ حال نختم هذا الحديث الآن بضرورة الاستفادة من هذه الفكرة، يعني: لئن كانت القيم والمثل والأهداف والاعتبارات، إذا بقيت عقليّةً محضةً، فهي سوف تصبح قليلة الفهم، ضعيفة الجذب بالنسبة إلى الإنسان، وكلّما أمكن تجسيدها حسّيّاً أصبحت أقوى، وأصبحت أكثر قدرةً على الجذب والدفع.
إذا كان هذا حقّاً، فيجب أن نخطّط لأنفسنا، ونخطّط في علاقتنا مع الآخرين على هذا الأساس، يجب أن نخطّط في أنفسنا على هذا. يعني: أن لا نكتفي بأفكار عقليّة نؤمن بها، نضعها في زاوية عقلنا كإيمان الفلاسفة بآرائهم الفلسفيّة، لا يكفي أن نؤمن بهذه القيم والمثل إيماناً عقليّاً صرفاً، بل يجب أن نحاول أن نستنزلها إلى أقصى درجة ممكنة من الوضوح الحسّي.
طبعاً، نحن لا نطمع أن نكون أنبياء، لا نطمع أن نحظى بهذا الشرف العظيم الذي انغلق على البشريّة بعد وفاة النبي (صلّى الله عليه وآله)، ولكن مع هذا: (الوضوح) مقولٌ بالتشكيك على حسب اصطلاح المناطقة(9).
ليس كلّ درجة من الوضوح معناها النبوّة، هناك ملايين من درجات الوضوح قبل أن تصبح نبيّاً، يمكن أن تكسب ملايين من درجات الوضوح -ملايين من الدرجات وهذه المراتب المتصاعدة- قبل أن تبلغ إلى الدرجة التي أصبح فيها موسى[ (عليه السلام)] في لحظةٍ استحقّ فيها أن يخاطبه الله تعالى، أو قبل أن تصل إلى الدرجة التي بلغ إليها محمّد (صلّى الله عليه وآله) حينما هبط عليه أشرف كتب السماء.
هناك ملايين من الدرجات، وهذه الملايين بابها مفتوحٌ أمامنا، ولا بدّ لنا أن لا نقتصر، أن لا نزهد في هذا التطوير العقلي للقيم والمثل الموجود عندنا، لا بدّلنا أن نطمع في أكثر من هذا من الوضوح، وفي أكثر من هذا من التحدّد ومن الحسّية، لابدّ لنا أن نفكّر في أن نُعبّئ كلَّ وجودنا بهذه القيم والمُثُل؛ لكي تكون على مستوى المحسوسات بالنسبة إلينا.
أساليب استنزال القيم العقليّة إلى مستوى المحسوسات:
من أساليب استنزال هذه القيم والمثل إلى مستوى المحسوسات هو التأكيد الذهني عليها باستمرار، هو الإيحاء بها، إيحاء الإنسان بها إلى نفسه باستمرار.
حينما توحي إلى نفسك باستمرار بهذه الأفكار الرفيعة، حينما توحي إلى نفسك باستمرار بأنّك عبدٌ مملوكٌ لله تعالى، وأنّ الله تبارك وتعالى هو المالك المطلق لأمرك وسلوكك ووجودك، وهو المخطِّط لوضعك ومستقبلك وحاضرك، وأنّه هو الذي يرعاك بعينٍ لا تنام في دنياك وفي آخرتك، حينما توحي إلى نفسك بهذه العبوديّة، وتوحي إلى نفسك باستمرار بمستلزمات هذه العبوديّة، من أنّك مسؤول أمام هذا المولى العظيم، مسؤول أن تطيعه، أن تطبّق خطّه، أن تلتزم رسالته، أن تدافع عن رايته، أن تَلْزَمَ شعاراته، حينما تُسِرُّ في نفسك وتؤكّد على نفسك باستمرار أنّ هذا هو معنى العبوديّة، وأنّك دائماً وأبداً يجب أن تعيش لله، حينما توحي إلى نفسك بأنّك يجب أن تعيش لله، سوف تتعمّق فكرة العيش لله في ذهنك، سوف تتّسع، سوف تصبح بالتدريج شبحاً يكاد أن يكون حسّيّاً بعد أن كان نظريّاً عقليّاً صرفاً.
أَلَيس هناك أشخاص من الأولياء والعلماء والصدّيقين قد استطاعوا أن يكشفوا محتوى هذه القيم والمثل باُمّ أعينهم؟ ولم يستطيعوا أن يكشفوها باُمّ أعينهم إلّا بعد أن عاشوها عيشاً تفصيليّاً مع الالتفات التفصيلي الدائم، وهذه عمليّة شاقّة جدّاً؛ لأنّ الإنسان -كما قلنا- ينفعل بالحسّ، وما أكثر المحسوسات من أمامه ومن خلفه، الدنيا كلّها بين يديه تُمتِّع حسَّه بمختلف الأشياء، هو يجب عليه دائماً وهو يعيش في هذه الدنيا التي تنقل إلى عينه مئات المبصَرات، وتنقل مئات المسموعات، يجب عليه أن يلقّن نفسه دائماً بهذه الأفكار، ويؤكّد هذه الأفكار، خاصّة في لحظات ارتفاعه، في لحظات تساميه؛ لأنّ أكثر الناس -إلّا من عصم الله- تحصل له لحظات التسامي وتحصل له لحظات الانخفاض.
لحظة الجلوة والانفتاح:
ليس كلّ إنسانٍ يعيش محمّداً[ (صلّى الله عليه وآله)] مئة بالمئة، وإلّا لكان كلُّ الناس من طلاّبه الحقيقيّين، كلّ إنسانٍ هو لا يعيش محمّداً (صلّى الله عليه وآله) إلّا لحظاتٍ معيّنةً تتّسع وتضيق بقدر تفاعل هذا الإنسان برسالة محمّد (صلّى الله عليه وآله).
إذاً، ففي تلك اللحظات التي تمرّ على أيّ واحدٍ منّا، ويحسّ بأنّ قلبه منفتحٌ لمحمّد (صلّى الله عليه وآله)، وأنّ عواطفه ومشاعره كلّها متأجّجة بنور رسالة هذا النبيّ العظيم، في تلك اللحظات يغتنم تلك الفرصة ليختزن، وأنا اُؤمن بعمليّة الاختزان، يعني اُؤمن بأنّ الإنسان في هذه اللحظة إذا استوعب أفكاره وأكّد على مضمونٍ معيّنٍ وخَزَنه في نفسه، سوف يفتح له هذا الاختزان في لحظات الضعف بعد هذا، حينما تفارقه هذه الجلوة العظيمة، حينما يعود إلى حياته الاعتياديّة، سوف يتعمّق بالتدريج هذا الرصيد، هذه البذرة التي وضعها في لحظة الجلوة، في لحظة الانفتاح المطلق على أشرف رسالات السماء، تلك البذرة سوف تشفعه، سوف تقول له في تلك اللحظة: إيّاك من الانحراف، إيّاك من المعصية، إيّاك من أن تنحرف قيد أنملةٍ عن خطّ محمّدٍ (صلّى الله عليه وآله).
كلّما يربط الإنسان نفسه في لحظات الجلوة، في لحظات الانفتاح، إذا ربط نفسه بقيود محمّدٍ (صلّى الله عليه وآله)، إذا استطاع في لحظةٍ من اللحظات -من هذه اللحظات- أن يعاهد نبيَّه العظيم على أن لا ينحرف عن رسالته، على أن لا يتململ عن خطّه، على أن يعيشه ويعيش أهدافه ورسالته وأحكامه، حينئذٍ، بعد هذا، حينما تفارقه هذه الجلوة -وكثيراً ما تفارقه- إذا أراد أن ينحرف يتذكّر عهده، يتذكّر صلته بالنبي[ (صلّى الله عليه وآله)]، تصبح العلاقة حينئذٍ ليست مجرّد عقل، مجرّدَ نظريّةٍ عقليّة، بل هناك اتّفاق، هناك معاهدة، هناك بيعةٌ أعطاها لهذا النبي في لحظة حسّ، في لحظةٍ قريبةٍ من الحسّ، كان كأنّه يرى النبيَّ أمامه فبايعه.
لو أنّ أيَّ واحدٍ منّا رأى النبي[ (صلّى الله عليه وآله)]، استطاع أن يرى النبي[ (صلّى الله عليه وآله)] باُمّ عينيه، أو رأى صاحب الأمر (عليه الصلاة والسلام).. تصوّروا أنّ أيّ واحدٍ منّا لو اُتيح له هذا الشرف العظيم ورأى إمامَه، إمامَ زمانه، رأى قائده باُمّ عينيه، وعاهده وجهاً لوجه على أن لا يعصي، على أن لا ينحرف، على أن لا يخون الرسالة، هل بإمكان هذا الإنسان بعد هذا -ولو فارقته تلك الجلوة، ولو ذهب إلى ما ذهب، ولو عاش أيَّ مكانٍ وأيَّ زمان- هل يمكنه أن يعصي؟ هل يمكنه أن ينحرف؟ أو يتذكّر دائماً صورة وليّ الأمر! صورة الإمام (عليه السلام) وهو يأخذ منه هذه البيعة! يأخذ منه هذا العهد!
نفس هذه العمليّة يمكن أن يعملها أيُّ واحدٍ منّا، لكن في لحظة الجلوة، في لحظة الانفتاح.
كلّ إنسانٍ منّا يعيش لحظة لقاء الإمام من دون أن يلقى الإمام، ولو مرّةً واحدةً في حياته، هذه المرّة الواحدة أو المرّتان أو الثلاثة يجب أن نعمل لكي تتكرّر؛ لأنّ بالإمكان أن نعيش هذه اللحظة دائماً، هذا ليس أمراً مستحيلاً، بل هو أمرٌ ممكن، والقصّةُ قصّةُ إعدادٍ وقصّةُ تهيئةٍ لأنْ نعيش هذه اللحظة، لأنْ نوسّع هذه اللحظة [في] حياتنا، لكي تأخذَ كلَّ حياتنا أو الجزءَ الأكبرَ من حياتنا.
لكن حتّى في حالة عدم توسعة هذه اللحظة، حتّى في حالة وجود لحظاتٍ أكثر بكثيرٍ نعيش فيها الدنيا، نعيش فيها أهواء الدنيا ورغبات الدنيا وشهوات الدنيا، مع هذا يجب أن تخلّف فينا تلك اللحظة رصيداً، يجب أن تخلّف فينا بذرةً، منعةً، عصمةً، قوّةً قادرةً على أن تقول: «لا» حينما يقول الإسلام: «لا»، «لا تُقدِم» حينما يقول الإسلام: «لا تُقدِم»، أو: «أقدِم» حينما يقول الإسلام: «أقدِم»، هذه اللحظة يجب أن نغتنمها، ويجب أن نختزن؛ لكي تتحوّل -بالتدريج- هذه المفاهيمُ إلى حقائق، وهذه الحقائق إلى محسوسات، وهذه المحسوسات إلى وجود نعيشه بكلّ عواطفنا ومشاعرنا وانفعالاتنا آناء الليل والنهار.
هذه هي تجربتنا نحن، يعني: نحن بيننا وبين أنفسنا، ونحن ما أحوجنا إلى ذلك؛ لأنّ المفروض أنّنا نحن الذين يجب أن نبلّغ للناس، نحن الذين يجب أن نشعّ بنور الرسالة على الناس، نحن الذين يجب أن نرسم الطريق والدرب، نحدّدَ معالم الطريق للاُمّة، للمسلمين.
إذاً فما أحوجنا إلى أن يتبيّن لدينا الطريقُ تبيّناً حسّيّاً، تبيّناً أقرب ما يكون إلى تبيّن الأنبياء لطرقهم.
ليس عبثاً وليس صدفةً أنّ رائد الطريق دائماً كان إنساناً يعيش الوحي؛ لأنّه كان لا بدّ أن يعيش طريقه بأعلى درجةٍ ممكنةٍ من الحسّ حتّى لا ينحرف، حتّى لا يتململ، حتّى لا يضيع، حتّى لا يكون سبباً في ضلال الآخرين، ليس هذا صدفة.
إذاً، فلا بدّ لنا أن نطمع في أكبر درجةٍ ممكنةٍ -بالنسبة إلى ظروفنا وملابساتنا- من الحسّ، يجب أن ندعو، أن نتضرّع إلى الله دائماً بأنْ يفتح لنا، يفتح أمام أعيننا معالمَ الطريق، أن يرِيَنا الطريق رؤيةَ عينٍ، لا رؤية عقلٍ فقط، أن يجعلَ هذه القيمَ وهذه المثل، والطريقَ إلى تجسيد هذه القيم وهذه المثل، أن يجعلَه شيئاً محسوساً لكلّ منعطفات هذا الطريق ولكلّ صعوبات هذا الطريق، وما يمكن أن نصادفه في أثناء هذا الطريق، لا بدّ لنا أن نفكّر في أن نحصّل أكبر درجةٍ ممكنةٍ من الوضوح في هذا الطريق.
هذا بيننا وبين أنفسنا.
ما هي العبرة المتوخّاة
وأمّا العبرة التي نأخذها بالنسبة إلينا مع الآخرين: نحن أيضاً يجب أن نفكّر في أنّنا سوف لن نطمع في هداية الآخرين عن طريق إعطاء المفاهيم فقط، عن طريق إعطاء النظريّات المجرّدة فقط.
إعطاء النظريات المجرّدة، تصنيف الكتب العميقة، كلّ هذا لا يكفي، إلقاء المحاضرات النظريّة لا يكفي، [بل] لا بدّ لنا أن نبني تأثيرنا في الآخرين أيضاً على مستوى الحسّ، يجب أن نجعل الآخرين يحسّون منّا بما ينفعلون به انفعالاً طيّباً طاهراً رساليّاً؛ فإنّ الآخرين مثلنا، الآخرون هم بشر، والبشر ينفعلون بالحسّ أكثر ممّا ينفعلون بالعقل، فلا بدّ لنا إذاً أن نعتمد على هذا الرصيد أكثر ممّا نعتمد على ذلك الرصيد.
مائة كتاب نظري لا تساوي أن تعيش حياةً هي الحياةُ التي تمثّل خطَّ الأنبياء، حينما تعيش هذه الحياة بوجودك، بوضعك، بأخلاقك، بإيمانك بالنار والجنّة، إيمانُك بالنار والجنّة حينما ينزل إلى مستوى الحسّ، إلى مستوى الرقابة الشديدة، إلى مستوى العصمة، حينما ينزل إلى هذا المستوى يصبح أمراً محسوساً، يصبح هذا الإيمان أمراً حسّيّاً، حينئذٍ سوف يكهرب الآخرين، سوف يشعّ على الآخرين.
فلا بدّ لنا -في حياتنا مع الآخرين والتأثير على الآخرين- أن لا نطمع بالتأثير عليهم على مستوى النظريّات فحسب؛ فإنّ هذا وحده لا يكفي، وإن كان ضروريّاً أيضاً، ولكن يجب أن نضيف إلى التأثير على مستوى النظريّات تطهيرَ أنفسنا، وتكميلَ أرواحنا، وتقريبَ سلوكنا من سلوك الأنبياء (عليهم الصلاة والسلام) وأوصياء هؤلاء الأنبياء، لنستطيع أن نجسّد تلك القيم والمثل بوجودنا أمام حسّ الآخرين قبل أن نعطيها لعقول الآخرين، أو توأماً مع إعطائها لعقول الآخرين.
اللهمّ وفّقنا للسير في خطّ أشرف أنبيائك، والالتزام بتعاليمه.
المصادر :
1- معاني الأخبار: 333، الحديث 1؛ الخصال 524 :2، الحديث 13؛ جامع الأخبار: 179؛ البدء والتاريخ 1 :3؛ بحار الأنوار 32 :11، كتاب النبوّة، باب معنى النبوّة وعلّة بعثة الأنبياء، الحديث 24، 71 :77، كتاب الروضة، الباب 4، الحديث 1.
2- تنقيح المقال في علم الرجال 244 :16.
3- في نسخةٍ: «السَورة»، وهي: الحِدّة، فراجع: لسان العرب 384 :4.
4- المزار الكبير: 297، الباب 13 من القسم الثالث، الزيارة 14؛ بحار الأنوار 166 :102، كتاب المزار، الباب 57، الزيارة 5.
5- الأمالي (الصدوق): 275، المجلس 46، الحديث 11؛ بحار الأنوار 505 :22، تاريخ نبيّنا (صلّى الله عليه وآله)، الباب 2، باب وفاته وغسله والصلاة عليه، الحديث 4، / إعلام الورى بأعلام الهدى 269 :1.
6- الكافي 177 :1، الحديث 4، / الاختصاص: 328.
7- راجع: الفتاوى الواضحة للسي الشهيد محمد باقر الصدر: 756، .
8- تفسير ما بعد الطبيعة 36 :1/تلخيص كتاب ما بعد الطبيعة: 83؛ رسالة ما بعد الطبيعة: 98، تفسير ما بعد الطبيعة 1162 :2/ موسوعة الفلسفة (بدوي) 107 :1.
9- كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم 447 :1.
