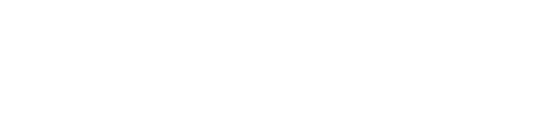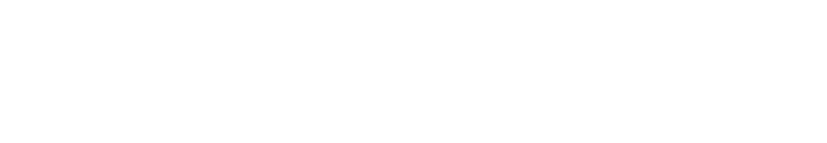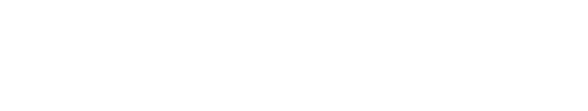لَقَدْ رَحَلَ النبيُّ الأكرمُ محمّد ـ صلَّى الله عليه وآله وسلم ـ في مطلع العام الحادي عشر الهجري بعد أنْ اجتهد طوال 23 سنة في إبلاغ الشريعة الإسلامية.
ومع رحيل النبيّ الأكرم ـ صلَّى الله عليه وآله وسلم ـ انقطعَ الوحيُ، وانتهت النُبوَّةُ، فلم يكن نبيٌّ بعده ولا شريعةٌ بعد شريعته، إلاّ أنّ الوظائف والتكاليف التي كانت على عاتق النبيّ محمد ـ صلَّى الله عليه وآله وسلم ـ (ما عدا مسألة تلقِّي الوحي وإبلاغه) لم تنته حتماً.
ولهذا كان يجب أن يكونَ بعد وفاته شخصيةٌ واعيةٌ وصالحةٌ تواصل القيام بتلك الوظائف والمهام وتقود المسلمين ويكون لهم إمامٌ خلافةً عن رسول الله ـ صلَّى الله عليه وآله وسلم ـ .
إنّ مسألة ضرورة وجود خليفة للنبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلم ـ موضعُ اتّفاق بين المسلمين، وإنْ اختلف الشيعة والسنة في بعض صفات ذلك الخليفة وطريقة تعيينه.
فلابدّ في البداية من توضيح معنى «الشيعة» و «التشيع»، وتاريخ نشأته وظهوره، ليتسنّى بعد ذلك البحثُ في المسائل المتعلّقة بالإمامة والخلافة بعد رسول الله ـ صلَّى الله عليه وآله وسلم ـ .
الأصلُ الثالث والثمانون: الشيعة لغة واصطلاحاً
«الشِيعَة» في اللغة بمعنى التابِع، وفي الاصطلاح تُطلَقُ هذه اللفظة أو التسمية على فريق من المسلمين يعتقدون بأنّ قيادة الأُمّة الإسلاميّةِ بعد وفاةِ رَسُول الله ـ صلَّى الله عليه وآله وسلم ـ هي من حق الإمام عليّ ـ عليه السَّلام ـ وأبنائه المعصومين.
وقد تَحَدّثَ النبيُّ الأكرمُ أيّام حياته عن فضائل الإمام عليّ ـ عليه السَّلام ـ ومناقبه، وكذا عن قيادته وزعامته للأُمّة الإسلاميّة من بعده، مراراً وفي مناسبات مختلِفة، بشهادة التاريخ المدوَّن.
إنّ هذه التوصيات والتأكيدات تسبَّبت ـ كما تحدِّثُنا الأحاديثُ الموثّقة ـ في أن يلتَفَّ فريقٌ مِنَ الصحابة حول الإمام عليّ ـ عليه السَّلام ـ في حياة النبي الأكرم ـ صلَّى الله عليه وآله وسلم ـ وتحبّه قلوبُهم، فتُعْرف بشيعةِ عليّ ـ عليه السَّلام ـ .
ولقد بقيت هذه الثُلّة من الصحابة على ولائها واعتقادها السابق بعد وفاة رسول الله ـ صلَّى الله عليه وآله وسلم ـ دون أنْ تؤثر المصالحَ الفرديّةَ على تنصيص رسول الله ـ صلَّى الله عليه وآله وسلم ـ ووصيَّته في مجال الخلافة وقيادة الأُمّة من بعده.
وهكذا سُمِّيَت جماعةٌ من المسلمين في عصر رسول الله، وبَعد حياته الشريفة ـ صلَّى الله عليه وآله وسلم ـ بالشيعة. وقد صَرحَ بهذا جماعةٌ من المؤلّفين في الملل والنحل.
فالنوبختي ( المتوفّى 310 هـ ) يكتب قائلاً: الشيعة هُم أتباع علي بنِ أبي طالب ـ عليه السَّلام ـ المسَمُّون بِشيعةِ علي ـ عليه السَّلام ـ في زمان النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلم ـ وبعده، معروفون بانقطاعهم إليه والقول بإمامته([1] ).
وقال أبو الحسن الأَشعري: وإنّما قيل لهم (شيعة) لأنّهم شايعوا عليّاً، ويقدّمونه على سائر أصحاب رسول الله ـ صلَّى الله عليه وآله وسلم ـ ([2] ) .
وقال الشهرستاني: الشيعة هم الذين شايَعوا علِيّاً على الخصوص، وقالوا بإمامته وخلافتِهِ نصّاً ووصيّة.([3] )
وعلى هذا الأساس فليس للشيعة تاريخ غير تاريخ الإسلام وليس له مبدأُ ظهور غير مبدأ ظهور الإسلام نفسه، وفي الحقيقة إنّ الإسلام والتشيّع وَجْهان لعُملة واحدة أو وَجهان لحقيقة واحدة، وتوأمان وُلدا في زَمَن واحد.
وقد ذكر المحدّثون والمؤرّخون أنّ النبيَّ ـ صلَّى الله عليه وآله وسلم ـ دعا في السَنَوات الأُولى من دعوته بني هاشم، وجمعهم في بيته وأعلن فيهم عن خلافة عليّ ووصايته (في ما يسمّى بحديث بَدء الدعوة أو يوم الدار)([4] ) وأعلن عن ذلك للناس فيما بعد مكرّراً، وفي مناسبات مختلفة ومواقف متعدّدة، وبخاصة في يوم الغدير، الّذي طرح فيه خلافة علي بصُورة رسميّة، وأخذَ البيعة من النّاس له وسيوافيك تفصيله.
إنّ التشيُّع ليس وليدَ حوادث السقيفة ولا فتنة مصرع عثمان وغيرها من الأساطير، بل انّ النبي الأكرم ـ صلَّى الله عليه وآله وسلم ـ هو الذي بذر بذرة التشيع لأَوّل مرة وغرس غرستها في قلوب الصحابة بتعاليمه السماوية المكرّرة.
ونمت تلك الغرسة فيما بعد شيئاً فشيئاً، وعُرِف صحابةٌ كبارٌ كأبي ذرّ، وسلمان، والمقداد، باسم الشيعة.
وقد ذكر المفسرون في تفسير قوله تعالى: ( إنَّ الَّذِينَ آمَنوا وعَمِلُوا الصّالِحاتِ أُوْلئكَ هُمْ خَيْرُ البَريّةِ) ([5] ) .
على أنّه لا تَسَعُ هذه الرسالةُ المختصرةُ لذكر أسماء الشيعة الأوائل من الصَّحابة، والتابعين الذين اعتَقَدُوا بخلافَتِهِ للنبِيّ ـ صلَّى الله عليه وآله وسلم ـ بصورة مباشرة وبلا فصل.
إنّ التشيُّعَ بالمفهوم المذكور هو الوجه المشترك بين جميع الشيعة في العالم، والذين يشكّلون قِسماً عظيماً مِن مُسْلِمِي العالم.
ولقد كانَ للِشيعة جنباً إلى جنب مع سائر المذاهب الإسلامية وعلى مدى التاريخ الإسلامي إسهامٌ عظيمٌ في نشر الإسلام، وقَدَّمُوا شخصيات عِلميّة وأَدَبيّة وسياسيّة جدّ عظيمة إلى المجتمع البشري ولهم حضور فاعل في أكثر نقاط العالم الراهِن أيضاً.
الأصلُ الرابعُ والثمانون: الإمامة مسألة إلهية
إنّ مسألةَ «الإمامة» ـ كما سنثبِتُ ذلك من خلال الأُصول القادمة ـ كانت مسألة إلهيّة، وسماويّة، ولهذا كان من اللازم أن يتم تعيينُ خليفة النبي كذلك عبر الوحي الإِلهيّ إلى النبيّ ـ صلَّى الله عليه وآله وسلم ـ ، ويقوم النبيُّ بإبلاغه إلى الناس.
وقبل أن نعمدَ إلى استعراض وبيان الأدلّةِ النقليّة والشرعيّة في هذا المجال، نستعرض حُكم العقلِ في هذه الحالة، آخذين بنظر الاعتبار ظروف تلك الفترة (أي فترة ما قبل وما بعد رحيل النبيّ)، وملابساتها.
إنَّ العقلَ البديهيَّ يحكم بأنّ أي إنسان مصلح إذا استطاع من خلال جهود مُضنية دامت سَنَوات عديدةً، من تنفيذ أُطروحة اجتماعيّة خاصة له، وابتكر طريقة جديدة للمجتمع البشريّ فإنّه لا بدّ من أن يفكِّر في وسيلة مؤثِّرة للإبقاء على تلك الأُطروحة، وضمان استمرارها، بل رُشدها، ونموّها أيضاً، وليس من الحكمة أن يؤسّسَ شخصٌ مّا بناءً عظيماً، متحمّلاً في ذلك السبيل متاعبَ كثيرة، ولكن لا يفكِّر فيما يقيه من الأخطار، ولا ينصب أحداً لصيانته والعناية به، من بعده.
إنَّ النبيَّ الأكرم ـ صلَّى الله عليه وآله وسلم ـ ، وهو من أكبر الشخصيّات العالميّة في تاريخ البشريّة، قد أوجَد ـ بما أتى من شريعة ـ أرضيّةً مساعدةً لتحوّل إلهيّ عالمي كبير، ومَهَّدَ لقيام حضارة جدُّ حديثة، وفريدة.
إنّ هذه الشخصيّة العظيمة، التي طَرَحَت على البشريّة شريعةً خالدةً، وقادت المجتمعَ البشريّ في عصرِهِ وأيام حياته، من المسلَّم أنّه فَكَّر لحفظ شريعته من الأخطار والآفات المحتملة التي تهدِّدها في المستقبل، وكذا لهداية أُمّته الخالدة، وإدارتها، وبيّن صيغة القيادة من بعده، وذلك لأنّه من غير المعقول أن يؤسّس هذا النبيُ الحكيمُ قواعدَ شريعة خالدة أبديّة، دون أنْ يطرح صيغة قويّة لقيادتها من بعده، يضمن بها بقاء تلك الشريعة.
إنَّ النبيَّ الَّذي لم يألُ جُهداً في بيان أَصغر ما تحتاج إليه سعادةُ البشرية، كيفَ يُعقَل أنْ يسكتَ في مجال قيادة المجتمع الإسلامي وصيغتها، وكيفيتها، والحال أنها من المسائل الجوهريّة، والمصيريّة، في حياة الأُمّة، بل وفي حياة البشريّة، وفي الحقيقة يترك المجتمعَ الإسلاميَّ حيارى مهمَلين، لا يَعرِفون واجبهم في هذا الصعيد؟!
وعلى هذا الأساس لا يمكن مطلقاً القبولُ بالزَّعم القائل بأنَّ النبيّ الأكرم أغمض عينيه عن الحياة دون ان ينبس ببنت شفة في مجال قيادة الأُمّة.
الأصلُ الخامسُ والثمانون: الإمامة والخطر الثلاثي المشؤوم: الروم والفرس والمنافقون
إنّ مراجعةَ التاريخ، وأخذِ الظروف التي كانت تحيط بالمنطقة، وبالعالم في زمان رحيل النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلم ـ وقُبَيل وفاتهِ بالذات بنظر الاعتبار تثبت ـ بِوُضوحـ بداهة وضرورةَ «تنْصيصيَّة» منصب الاَمامة وذلك لأنّ أخطاراً ثلاثة كانت تهدّد الدينَ والكيانَ الإسلاميَّ، وتحيط به على شكلِ مُثَلّث مَشؤُوم.
الضِلعُ الأوَّل مِن هذا المثلَّث الخَطِر كان يتمثَّل في الإمبراطورية الروميّة.
والضلع الثانِي كانَ يَتمثّل في الإمبراطوريّة الفارسيّة.
والضلعُ الثالث كان يَتَمثَّل في فريق المنافقين الداخِلِيّين.
وبالنسبة لخَطَر الضلعِ الأوّل، وأهميّته القُصْوى يكفي أنَ نعلمَ أنّ النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلم ـ لم يزل يفكر فيه حتى آخر لحظة من حياته، ولهذا جهّزَ ـ قُبَيل أيّام بل ساعات من وفاته ـ جيشاً عظيماً بقيادة «أُسامة بن زيد» وبَعَثَه لمواجهة الروم، كما ولَعَنَ مَن تَخلَّفَ عنه أيضاً.
وبالنسبة لخطَر الضِلعِ الثاني يكفي أن نعرفَ أنّه كان عَدُوّاً شرساً أيضاً أقدمَ على تمزيقِ رسالةِ النبيّ ـ صلَّى الله عليه وآله وسلم ـ وكتب إلى حاكم اليمن بأنْ يقبضَ على رسولِ اللهِ ـ صلَّى الله عليه وآله وسلم ـ ، ويبعث به إليه، أو يرسلَ إليه برأسه.
وبالتالي بالنسبة إلى الخَطَر الثالث يجب أن نعلمَ أنّ هذا الفريق (أي المنافقين) كان يقوم في المدينة بمزاحمة النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلم ـ باستمرار وكان المنافقون هؤلاء يؤذونه بالمؤامرات المتنوعة، ويعرقلون حركته، وقد تحدّث القرآنُ الكريمُ عنهم وعن خصالهم، ونفاقهم، وأَذاهم، ومحاولاتهم الخبيثة في سوره المختلفة إلى درجة انّه سمّيت سورة كاملة باسمهم، وهي تتحدّث عنهم وعن نواياهم وأعمالِهم الشرّيرةِ.
والآن نطرحُ هذا السؤالَ وهو: هل مع وجودِ هذا المثلَّث الخَطِر كانَ من الصحيحِ أنْ يترك النبيُ الأكرمُ ـ صلَّى الله عليه وآله وسلم ـ الأُمّة الإسلاميةَ، والدينَ الإسلاميَ اللّذَين كانا محاطَين بالأخطار من كلّ جانب، وكان الأعداءُ لهما بالمرصاد من كلّ ناحية، من دونِ قائد معيّن؟!!
إنّ النبيَّ ـ صلَّى الله عليه وآله وسلم ـ ولاشكَّ كانَ يَعْلَم أن حياةَ العرب حياة قَبَليّة، عشائرية وأنّ أفرادَ هذه القبائِل كانَتْ مُتَعَصِبّة لرؤساء تلك القبائل، فهم كانوا يطيعون الرؤساء بشدّة، ويخضَعُون لهُمْ خضوعاً كبيراً، ولهذا فإنَّ ترك مِثل هذا المجتمع مِن دون نصبِ قائد معيّن سوف يؤدّي إلى التشتت والتنازع بين هذه القبائل، وسيستفيد الأعداء من هذا التخاصُم والتَنازع، والإختلاف .
وانطلاقاً من هذه الحقيقة قال الشيخ الرئيس أبو علي بن سينا: «الاستخلاف بالنصّ أصوب، فإنّ ذلك لا يؤدي إلى التشعّب والتشاغب والاختلاف»([7] ).
الأصلُ السادسُ والثمانون: تعيين الإمام والخليفة في أحاديث الرسول ـ صلَّى الله عليه وآله وسلم ـ
والآن وَبعدَ أنْ ثَبَتَ أنَّ حِكمةَ النبيّ وعلمهُ كانا يقتَضِيانِ بأن يتخذ موقفاً مناسِباً في مجالِ الِقيادة الإسلاميّة مِن بَعدِهِ، فَلْنرَى ماذا كانَ الموقف الذي اتخذه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلم ـ في هذا الصعيد؟
هُناكَ نظريَّتان في هذا المَجال نُدرِجُهُما هنا، ونعمَدُ إلى مناقشتهما:
النظرية الأُولى: انّ النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلم ـ اختار بأمرِ الله تعالى شخصاً مُمتازاً صالِحاً لقيادةِ الأُمّة الإسلامِيّة، ونَصَبَهُ لِخلافَتهِ وأخبرَ النّاسَ بذلك.
النظرية الثانية: أنّ النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلم ـ أوكَلَ اختيار القائد والخليفة من بعده إلى النّاس، انفسِهِم، لينتَخِبوا ـ هم بأنفسِهِم ـ شخصاً لهذا المنصب.
والآن يجب أن نرى أيّة واحدة من النظريتين تُستفاد من الكِتابِ والسُّنة والتاريخِ؟
إنَّ الإمعانَ في حياة النبيّ ـ صلَّى الله عليه وآله وسلم ـ مُنذ أن كُلّف بتبليغِ شرِيعتهِ إلى أقربائِهِ وعَشيرته، ثم الإعلان عن دعوتهِ إلى النّاس كافّة، يفيد أن النبيّ ـ صلَّى الله عليه وآله وسلم ـ سلك طريق «التنصيص» في مسألة القيادة، والخلافة، مراراً، دون طريق «الإنتخاب الشعبيّ» وهذا الموضوع نثبتهُ من خلال الأُمور التالية:
1. حديث يوم الدار
بعد أن مضت ثلاثُ سَنَوات على اليوم الذي بُعِثَ فيه رسول الله ـ صلَّى الله عليه وآله وسلم ـ ، كَلّفهُ اللهُ تعالى بأن يبلّغَ رسالَتَه لأبناءِ قَبيلتِهِ، وذلك عندما نَزَل قولهُ عز وجلّ: ( وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ) ([8] ) .
فَجَمَع النبيُّ ـ صلَّى الله عليه وآله وسلم ـ رؤوسَ بني هاشم وقال : «يا بني عبد المطّلب إنّي واللهِ ما أعلمُ شابّاً في العَرَبِ جاء قومَه بأفضل ممّا قد جئتكم به إنيّ قد جئتكُم بخَيِر الدُنيا والآخِرة وقد أمَرَنيَ اللهُ تعالى أنْ أدعوكم إليه فأيُّكم يؤازرني على هذا الأمر يكون أخي ووصيي ووزيري وخليفتي فيكم». ولقد كرّر النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلم ـ العبارة الأخيرة ثلاثَ مرّات، ولم يقمْ في كلّ تلك المرّات إلاّ الإمامُ علي ـ عليه السَّلام ـ ، الّذي أعلَنَ عن استعدادِهِ في كلّ مرّة لمؤازرةِ النَبيّ ـ صلَّى الله عليه وآله وسلم ـ ونُصْرته، وفي المرّة الثالِثة قال النبيُّ ـ صلَّى الله عليه وآله وسلم ـ : «إنَّ هذا أخِي وَوَصيِّي وخَلِيفَتِي فِيكُمْ فَاْسمَعوا لَه وأطيعُوا»([9] ).
2. حَديِثُ المَنْزِلَةِ
لَقد اعتبر النبيُّ ـ صلَّى الله عليه وآله وسلم ـ منزلةَ «عليّ ـ عليه السَّلام ـ » منه على غرارِ منزلةِ هارون من موسى ـ عليهما السَّلام ـ ، ولم يستثنِ من منازِلِ ومراتبِ هارون من موسى إلاّ النبوّة حيث قال: «يا عليّ أما ترضى أن تكونَ مِنّي بمنزلةِ هارونَ من مُوسى إلاّ أنّه لا نبيَّ بعدي»([10] ) وهذا النفي والسَلب هو في الحقيقة من بابِ «السالبة بإنتفاءِ الموضوعِ». اذ لم تكن بعد رسولِ الله الخاتم ـ صلَّى الله عليه وآله وسلم ـ نبوّةٌ حتى يكونَ عليٌ نبيّاً من بعده إذ بنُبُوّة رسولِ الإسلام خُتمت النبوّات، وبِشريعتِهِ خُتِمت الشّرائِع.
ولقد كانَ لِهارون ـ بنَصّ القرآنِ الكريمِ ـ مقامُ «النبوّة»([11] ) و «الخلافة»([12] ) و«الوزارة »([13] ) في زمانِ مُوسى، وقد أثبتَ حديثُ «المنزلة» جميعَ هذه المناصب الثابتة لهارون للإمام عليّ ـ عليه السَّلام ـ ما عدا النُبُوَّة، على أنّه إذا لم يكن المقصودُ مِن هذا الحَديث هو إثباتُ جميعِ المناصبِ والمقاماتِ لعليّ إلاّ النبوَّة، لم يكنْ أيّة حاجة إلى استثناء النُبوّة.
3. حَدِيثُ السَّفِينَةِ
لقد شَبَّه النبيُّ الأكرمُ ـ صلَّى الله عليه وآله وسلم ـ أهلَ بيته بِسَفينةِ نوح الّتي من رَكبها نجا، ومن تخلّف عنها غرق في الطوفانِ كما قال: «ألا إنّ مَثَل أهلِ بيتي فِيكم مَثلُ سَفينة نُوح في قومه مَن رَكبها نَجا، ومَن تَخلَّفَ عَنها غرِق»([14] ).
ونحنُ نَعلمُ أنّ سَفينة «نوح» كانت هي الملجأ الوحيد لنجاة الناس من الطوفان في ذلك الوقت.
وعلى هذا الأساس فإنّ أهلَ البيت النبويّ ـ وفقاً لحديث سفينة نوح ـ يُعتَبرُون الملجأ الوَحيد للأُمّة للنجاة من الحوادث العصيبة والوقائع الخطيرة التي طالما تُؤدّي إلى انحراف البشرية وضلالها.
4. حديث «أمان الأُمّة»
لقدَ وَصَفَ النبيُّ ـ صلَّى الله عليه وآله وسلم ـ أهل بيته بكونهم سَبَباً لوحدة المسلمين، وممّا يوجِبُ ابتعادهم عن الإختلاف والتَشتّت وأماناً من الغَرق في بحر الفِتنة، إذ قال: «النجومُ أمانٌ لأهل الأرض من الغَرَق وأهلُ بَيتي أمانٌ من الإختلاف، فإذا خالَفتها قبيلةٌ مِنَ العَرَب اختَلَفوا فصارُوا حزب إبليس»([15] ).
وبهذا شبّه النبيُّ ـ صلَّى الله عليه وآله وسلم ـ أهل بيته الكرام بالنجوم التي يقول عنها اللهُ سبحانه: ( وبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُون) ([16] ) .
5. حَديثُ الثَقَلَين
إنّ حديثَ الثَقَلينِ مِنَ الأحاديث الإسلاميّة المتواترة، الّتي نَقَلها وَرَواها علماءُ الفريقين في كتبهم الحديثية.
فقد خاطَبَ رسولُ الله ـ صلَّى الله عليه وآله وسلم ـ الأُمّة الإسلامية قائلا: «إنّي تاركٌ فيكُم الثَقَلَيْن كتابَ الله وَعِتْرَتي أهلَ بَيْتي ما إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بهما لَنْ تَضلُّوا أبَداً وإنّهما لَنْ يَفْتَرِقا حَتى يَرِدا عَلَيَّ الحَوْضَ»([17] ).
إنّ هذا الحديثَ، يُثبتُ ـ بوضوح ـ المرجَعيّة العِلميّة لأهلِ البَيْت النَبَويّ جَنْباً إلى جنب مع القرآن الكريم، وَيُلزِمُ المُسلمين بأن يتمسَّكُوا ـ في الأُمور الدينيّة ـ بأهل البيت إلى جانب القرآن الكريم، ويلتمسوا رأيهم.
ولكنّ المؤسفَ جدّاً أن يَلتَمس فريقٌ من النّاس رأيَ كلّ أحد إلاّ رأيَ أهلِ البيت، ويطرقوا بابَ بَيْت كلّ أحد إلاّ باب بيتِ أهل البيت ـ عليهم السَّلام ـ .
إنّ «حديث الثقلين» الذي يتفق على روايته الشيعةُ والسنةُ يمكنهُ أن يجمع جميع مسلمي العالم حول محور واحد، لأنّه إذا ما اختلفَ الفريقان في مَسألة تعيين الخليفة والقائد، والزعيم السياسي للأُمّة بعد رسول الله ـ صلَّى الله عليه وآله وسلم ـ وكان لكلّ فريق نظريّته وآلَ الاستنباطُ التاريخيّ في هذا الصعيد إلى انقسام المسلمين إلى فريقين، فإنّه لا يوجَدُ هناك أيُّ دليل للإختلاف في مرجَعيّة أهلِ البيت العلِميّة، ويجب أن يكونوا ـ طِبقاً لحديث الثقلين المتَّفَق عليه ـ متفقين على كلمة واحدة.
وأساساً كانت مرجعيَّة أهلِ البَيت العلميّة في عَصر الخُلَفاء لعليّ ـ عليه السَّلام ـ أيضاً، فقد كانوا يرجعون إليه عند الإختلاف في المسائل الدينيّة وكانت المشكلة تُحلُّ بواسطته.
وفي الحقيقة منذُ أن عُزل أهلُ بيت النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلم ـ عن ساحة المرجَعيّة العلميّة ظهرَ التفرُّقُ والتشرذُمُ، وبرزت الفِرَقُ الكلامِيّةُ المتعدّدةُ الواحدةُ تلو الأُخرى.
الأصلُ السابعُ والثمانون: حديث الغدير
كان رسولُ الله ـ صلَّى الله عليه وآله وسلم ـ ـ كما يبدو في الأحاديث السالفةُ ـ يعرّف بخليفته ووصيه تارةً بصورة كليّة، وأُخرى بصورة معيّنة، أي بذكر اسم الخليفة والوصيّ بحيث يمثّلُ كلُ واحد من تلك الأحاديث حجةً كاملةً وتامّةً لمن يطلبُ الحقيقة وهو شهيدٌ واع. ولكن مع ذلك ولكي يُوصِلَ النبيُّ ـ صلَّى الله عليه وآله وسلم ـ نداءَه إلى كلّ قاص ودان من المسلمين في ذلك اليوم، ويرفعَ كلّ إبهام وغموض، ويدفع كلّ شك أو تشكيك في هذا المجال، توقّفَ عند قُفوله ومراجَعَته من حَجّة الوَداع في أرض تسمى بغدير خم، وأخبر من مَعَه من الحجيج بأنّه كُلِّف مِن جانب الله تعالى بأن يُبلِّغ رسالة إليهم، وهي رسالة تحكي عن القيام بأمر جدّ عظيم، بحيث إذا لم يُبلِّغها يكون كأنّه لم يُبَلّغ شيئاً من رسالته كما قال تعالى:
( يَا أَيُّها الرَّسُولُ بَلّغْ ما أُنزِلَ إليكَ مِن رَّبِكَ وإن لَم تَفْعَلْ فَماَ بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللهُ يعصِمُكَ مِنَ النَّاسِ) ([18] )([19] )
ثم رقى النبيُّ منبراً من أقتاب الإبل وحُدُوجها، وقال ـ صلَّى الله عليه وآله وسلم ـ مخاطباً الناس: «يوشك أنْ اُدعى فأجيب فماذا أنتم قائلون؟»
قالوا: نَشهدُ أنّك قد بَلّغتَ ونَصحتَ وجَهَدتَ فجزاك اللهُ خيراً. فقال ـ صلَّى الله عليه وآله وسلم ـ : «ألَسْتم تَشهَدون أن لا إله إلاّ الله وأنّ محمّداً عَبدُه ورسولهُ وان الساعة آتيةٌ لا ريبَ فيها؟»
قالوا: بَلى نَشْهدُ بذلك.
قالَ ـ صلَّى الله عليه وآله وسلم ـ : «فإنّي فَرَطٌ (أي أسبقكُم) على الحوض (أي الكوثر)، فَانظُرُوا كيفَ تَخلِفوُني في الثَقَلَين؟»
فنادى مناد: وما الثَقَلان يا رَسولَ الله ؟
قالَ ـ صلَّى الله عليه وآله وسلم ـ : «الثَقَلُ الأكبر كتابُ الله طَرَفٌ بيدِ اللهِ عزَّ وجَلَّ وطَرَفٌ بأيدِيكُمْ فتمَسَّكُوا به لا تَضِلُّوا، والآخَرالأصغَر عترتي، وإنّ اللطيفَ الخبيرَ نبّأني أَنَّهما لنْ يفترقا حتى يَردا عليَّ الحَوضَ، فلا تقدمُوهُما فتَهلكوا، ولا تقصِّروا عنْهما فَتَهْلَكُوا».
ثم أخذ بيد «عليّ» فَرفَعها حتى رؤي بياضُ آباطهما فعرفَه القومُ أجمعون فقال ـ صلَّى الله عليه وآله وسلم ـ : «أيُّها الناسُ من أولى النّاس بالمؤْمِنين من أنفسِهِم؟»
قالوا: اللهُ ورسولهُ أعلمُ.
قال ـ صلَّى الله عليه وآله وسلم ـ : «إنّ الله مولايَ، وأنا مَولى المؤمِنِين، وأنا أولى بِهِمْ مِن أنفسهِمْ، فَمَن كنتُ مَولاه فَعَلِيٌ مولاهُ».
ثم قال ـ صلَّى الله عليه وآله وسلم ـ : «اللّهُمَّ والِ مِن والاهُ، وعادِ من عاداهُ، وأحِبَّ من أحَبَّهُ، وابْغَضْ مَن أبْغَضَهُ، وانْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ، واخْذُلْ من خَذَلهَ، وأدِرِ الحقَّ معه حيث دارَ، ألا فَلْيُبَلّغِ الشّاهِدُ الغائبَ».
الأَصلُ الثامِنُ والثمانُون: حديث الغدير من الأحاديث المتواترة
إنّ حديثَ الغَدِير منَ الأَحاديثِ المتَواتِرة، وقد رَواهُ من الصَّحابة والتابعين وعُلماءِ الحديث في كلّ قرن بصورَة متواترة.
فقد نقل حديثَ الغدير ورواه (110) من الصحابة، و (89) من التابعين، و(3500) من العلماء والمحدِّثين، وفي ضوء هذا التواتر لا يبقى أيُّ مجال للشَكِ في أصالةِ، وصحّة هذا الحديث.
كما أَنّ فريقاً من العُلَماء ألَّفوا كُتباً مستَقِلّةً حولَ حديث «الغدير» أشْمَلُها وأكثرُها اسْتِيعاباً لِطُرق وأسنادِ هذا الحديث كتابُ «الغدير» للعلاّمة الشيخ عبد الحسين الأميني (1320 ـ 1390 هـ).
والآن يجب أن نَرى ما هو المقصود من لفظة «الموَلى» وماذا تَعني «مولويّة» عليّ ـ عليه السَّلام ـ ؟
إنّ القرائن والشواهدَ الكثيرةَ والعديدةَ تشهد بأنَّ المقصودَ من هذه اللَفظة، والكلمة هو: الزعامة والقيادة، وها نحن نشيرُ إلى بعض هذه الشَواهدِ والقرائن:
ألف: في واقعة الغدير، أمَرَ رسولُ الله ـ صلَّى الله عليه وآله وسلم ـ بأنْ يحطَّ الحُجّاج الّذين كانوا يرجعون معه من الحج، في أرض قاحِلة لا ماء فيها، ولا كلأ، وفي وقتِ الزوال، وتحت أشعّة الشَّمس الحارقة.
ولقد كانت حرارةُ الهَجير من الشِدّة في ذلك الوَقت بحيث أنّ الشخص من الحاضرين في ذلك المشهد كان يضع بعض عباءته تحت رجليه وبعضها فوق رأسه تَوقِّياً من شدّة الرَمضاء، وحرارة الشّمس.
من الطبيعي أن النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلم ـ كان يريد في هذه الحالة الخاصّة، أن يقول ماله دورٌ مصيريٌّ هامٌ في هداية الأُمّة.
ترى أي شيء يمكنه أن يكون له دور مصيريٌّ وهامٌّ في حياة المسلمين أكثر من تعيين القيادة التي توجب وحدةَ كَلِمةِ المسلمين، وتكونُ حافظة لدينهم.
ب : لقد تحدّث رسولُ الله ـ صلَّى الله عليه وآله وسلم ـ قبل ذكر مسألة ولاية الإمام علي ـ عليه السَّلام ـ عَن أُصول الدين الثلاثة: التوحيد، والنبوّة، والمعاد، وأخَذَ من الناس الإقرارَ بها، ثم طرَحَ مسألة ولاية الإمام علي ـ عليه السَّلام ـ بعد ذلك.
إنّ التقارن بين إبلاغ هذه الرسالة وأخذ الاعتراف والإقرار بالأُصول المذكورة يمكن أن يقودنا إلى معرفة أهميّة الرسالة التي أمَرَ النبيُّ بإبلاغِها إلى النّاس في «غدير خم»، ويمكن معرفة أنّ النبيّ ـ صلَّى الله عليه وآله وسلم ـ ما كانَ يقصُد مِن ذلك الإجتماع العظيم في تلك الظروفِ الإستثنائيّةِ والملابَسات الخاصّة التوصية فقط بمحبّة وموادّة شخص معيّن..
ج : قبل إبلاغِ الرِسّالة الإلهيّة في شأنِ عليٍّ ـ عليه السَّلام ـ تحدَّثَ النبيُّ ـ صلَّى الله عليه وآله وسلم ـ عن ولايَته ومولويَّتهِ وقال: اللهُ مولايَ وأنا مولى المْؤُمِنِين، وأنا أولى بِهِمْ مِن أنْفسِهِمْ.
إنّ ذكر هذه المطالب دليلٌ على أنّ «مولويّةَ الإمام علي ـ عليه السَّلام ـ » كانت من نمط وسنخ مولوية النبيّ ـ صلَّى الله عليه وآله وسلم ـ وأنّ النبي أثبت بأمر الله تعالى مَولويّته وأولويّته بالأمر لعليّ أيضاً.
د : إنّ النبيّ ـ صلَّى الله عليه وآله وسلم ـ قال بعد إبلاغ هذه الرِسّالة الإلهيّة: فَلْيبلّغِ الشاهدُ الغائبَ.