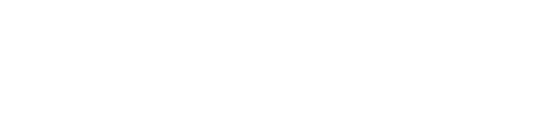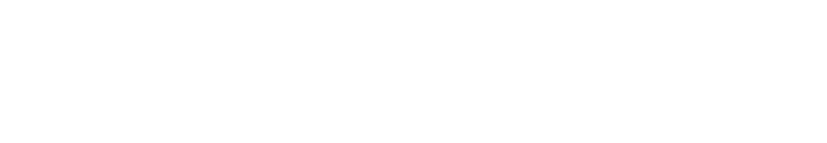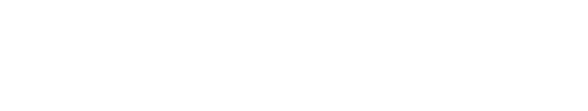اختلف الناس في مسألة تعليل أفعال الله، وإثبات الحكمة فيها من أجل مسائل التوحيد المتعلقة بالخلق والأمر، والشرع والقدر و فيها أقوال شتى، ولكنَّها ترجع إلى قولين.
أحدهما: قول نفاة الحكمة، وهو قول الأشاعرة ومن وافقهم ممن يرى أن الله عز وجل قدر المقادير، وشرع الشرائع لغير علة، أو حكمة، بل فعل ذلك لمحض المشيئة، وصرف الإرادة.
الثاني: قول الجمهور الذين يثبتون الحكمة، وأنَّ لله في كل ما يقضيه حكمةً ورحمة.
وهذه الحكمة تتضمن شيئين:
أحدهما: حكمة تعود إليه تعالى يحبها ويرضاها.
والثاني: حكمة تعود إلى عباده، فهي نعمة عليهم يفرحون، ويلتذون بها.
وهذا يكون في المأمورات، والمخلوقات
المطلب الأول: نسبة الشر إلى الله تعالى وحكم ذلك:
إذا سأل سائل فقال:
نحن نؤمن بالقدر خيره وشره من الله، فهل تصح نسبة الشر إلى الله تعالى ؟
وهل يقع في أفعاله شر؟
فالجواب: أن يُقال: إن الله سبحانه وتعالى منزَّه عن الشر، ولا يفعل إلا الخير، والقدر من حيث نسبته إلى الله لا شر فيه بوجه من الوجوه؛ فإنه علم الله، وكتابتُه، ومشيئته، وخلقُه، وذلك خير محض، وكمال من كل وجه، فالشر ليس إلى الرب بوجه من الوجوه، لا في ذاته، ولا في أسمائه ولا صفاته، ولا في أفعاله.
ولو فَعَلَ الشر سبحانه لاشتُق له منه اسم، ولم تكن أسماؤه كلها حسنى، ولعاد إليه من الشر حكمٌ تعالى وتقدس .
وإنما الشر يدخل في مخلوقاته، ومفعولاته، فالشر في المقضي، لا في القضاء، ويكون شرَّاً بالنسبة إلى محل، وخيراً بالنسبة إلى محل آخر، وقد يكون خيراً بالنسبة إلى المحل القائم به من وجه، كما هو شر من وجه آخر، بل هو الغالب، وهذا كالقصاص، وإقامة الحدود، وقتل الكفار؛ فإنه شرٌ بالنسبة إليهم لا من كل وجه، بل من وجه دون وجه، وخير بالنسبة إلى غيرهم لما فيه من مصلحة الزجر، والنكال، ودفع الناس بعضهم ببعض.
وكذلك الأمراض وإن كانت شروراً من وجه فهي خيرٌ من وجوهٍ عديدة.
والحاصل أن الشر لا يُنسب إلى الله تعالى ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن النبي " كان يثني على ربه بتنزيهه عن الشر بدعاء الاستفتاح في قوله: لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت
قال الإمام الصابوني في معنى هذا الحديث:ومعناه والله أعلم والشر ليس مما يُضاف إلى الله إفراداً أو قصداً حتى يُقال: يا خالق الشر، ويا مقدر الشر وإن كان الخالق والمقدر لهما جميعاً؛ لذلك أضاف الخضر عليه السلام إرادة العيب إلى نفسه فقال فيما أخبر الله عنه في قوله:
(أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا) (1)
ولمَّا ذكر الخير والبر والرحمة أضاف إرادتها إلى الله عز وجل فقال:
(فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ) (2)
ولذلك قال مخبراً عن إبراهيم عليه السلام أنه قال:
(وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ) (3)
فأضاف المرض إلى نفسه، والشفاء إلى ربه، وإن كان الجميع منه
وخلقُهُ، وفعلُه، وقضاؤه، وقدره خيرٌ كله؛ ولهذا تنزَّه سبحانه عن الظلم، الذي حقيقته وضع الشيء في غير موضعه، فلا يضع الأشياء إلا في مواضعها اللائقة بها، وذلك خير كله، والشر وضع الشيء في غير محله، فإذا وُضِع في محله لم يكن شرَّاً، فعُلم أن الشر ليس إليه، وأسماؤه الحسنى تشهد بذلك
فأسماؤه الحسنى تمنع نسبة الشر، والسوء، والظلم إليه، مع أنه سبحانه الخالق لكل شيء؛ فهو الخالق للعباد، وأفعالهم، وحركاتهم، وأقوالهم، والعبد إذا فعل القبيحَ المنهيَّ عنه، كان قد فعل الشرَّ والسوءَ.
والربُّ سبحانه هو الذي جعله فاعلاً لذلك، وهذا الجَعْل منه عدلٌ وحكمةٌ، وصوابٌ، فَجَعْلُهُ فاعلاً خيرٌ، والمفعولُ شرٌّ قبيح؛ فهو سبحانه بهذا الجعل قد وضع الشيء في موضعه؛ لما له في ذلك من الحكمة البالغة التي يحمد عليها، فهو خير وحكمة، ومصلحة، وإن كان وقوعه من العبد عيباً، ونقصاً، وشرَّاً
والحاصل أن الله تعالى لا يُنسب إليه الشر؛ لأنه إن أريد بالشر وضع الشيء في غير موضعه فهو الظلم، ومقابله العدل، والله منزَّه عن الظلم.
وإن أُريد به الأذى اللاحق بالمحل بسبب ذنب ارتكبه فإيجاد الله للعقوبة على ذنب لا يُعد شرَّاً له؛ بل ذلك عدلٌ منه تعالى .
وإن أُريد به عدم الخير، وأسبابه الموصلة إليه فالعَدَمُ ليس فعلاً حتى ينسب إلى الله، وليس للعبد على الله أن يوفقه، فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، ومنع الفضل ليس بظلم ولا شر
ثم إن على العبد إذا عرف ما يضره وينفعه أن يَذلَّ لله عز وجل حتى يعينه على فعل ما ينفعه، ولا يقول: أنا لا أفعل حتى يخلق الله فيَّ الفعل، كما أنه لو هجم عليه عدو أو سبع فإنه يهرب ويفر ولا يقول: سأنتظر حتى يخلق الله فيَّ الهرب
ومن هنا يتبين لنا أن الشر لا ينسب إلى الله عز وجل .
وهذا ما سيتضح في المباحث التالية.
قيل: إن المراد نوعان: مراد لنفسه، ومراد لغيره، فالمراد لنفسه مطلوب محبوب لذاته وما فيه من الخير؛ فهو مراد إرادة الغايات والمقاصد.
والمراد لغيره قد لا يكون مقصوداً لما يريد، ولا فيه مصلحة بالنظر إلى ذاته وإن كان وسيلة إلى مقصوده، ومراده فهو مكروه له من حيث نفسه وذاته، مراد له من حيث قضاؤه، وإيصاله إلى مراده؛ فيجتمع الأمران: بغضه، وإرادته، ولا يتنافيان، فيبغض من وجه، ويحب من وجه آخر.
وهذا أمر معلوم عند الخلق؛ فهذا الدواء الكريه الطعم والرائحة إذا علم الإنسان أن فيه شفاءَه أبغضه من وجه، وأحبه من وجه آخر؛ فيكرهه من جهة تألمه به، ويحبه من جهة إفضائه إلى ما يحب.
وقل مثل ذلك في العضو المتآكل إذا عَلِم أن في قطعه بقاءً لجسده، وكقطع المسافة الشاقة إذا عَلِم أنها توصل إلى مراده، ومحبوبه، كالذي يقطع الفيافي، والمفاوز، والقفار، قاصداً البيت العتيق.
ومن هنا يتبين لنا أن الشيء يجتمع فيه الأمران: بغض من وجه، وحب من وجه آخر، ولا يتنافيان، هذا في شأن المخلوق، فكيف بالخالق الذي لا تخفى عليه خافية، الذي له الحكمة البالغة؟ فهو سبحانه يكره الشيء، ولا يتنافى ذلك مع إرادته له لأجل غيره، وكونه سبباً إلى أمر محبوب .
خلق إبليس والحكمة من ذلك:
الله عز وجل خلق إبليس الذي هو مادة الفساد التي تمد كل فساد في هذه الدنيا، في الأديان، والاعتقادات، والشهوات، والشبهات، وهو سبب لشقاوة العباد، وعَمَلِهم ما يغضب الله عز وجل وهو مع ذلك كله وسيلة إلى محابَّ كثيرةٍ، وحكم عظيمة.
إذا تقرر ذلك فهذه بعض الحكم التي تلمسها العلماء من خلق إبليس:
1- أن يَظهر للعباد قدرةُ الرب تعالى على خلق المتضادات والمتقابلات: فخلق هذه الذات إبليس التي هي أخبث الذوات، وهي سبب كل شر، وخَلَق في مقابلها ذات جبريل التي هي من أشرف الذوات وأزكاها، والتي هي مادة كل خير، فتبارك من خلق هذا وهذا، كما ظهرت قدرته في خلق الليل والنهار، والحر والبرد، والماء والنار، والداء والدواء، والموت والحياة، والحسن والقبيح، فالضد يظهر حسنه الضد، وهذا أدلُّ دليل على كمال قدرته، وعزته، وملكه، وسلطانه؛ فإنه خلق هذه المتضادات، وقابل بعضها ببعض، وسلط بعضها على بعض، وجعلها محل تصرفه، وتدبيره، وحكمته، فخلوُّ الوجود عن بعضها بالكلية تعطيل لحكمته، وكمال تصرفه، وتدبير مملكته
2- أن يُكَمِّلَ الله لأوليائه مراتب العبودية: وذلك بمجاهدة إبليس وحزبه، وإغاظته بالطاعة لله، والاستعاذة بالله منه، واللجوء إلى الله أن يعيذهم منه ومن كيده، فيترتب لهم على ذلك من المصالح الدنيوية، والأخروية ما لا يحصل بدونه.
ثم إن المحبة، والإنابة، والتوكل، والصبر، والرضا، ونحوها أحب أنواع العبودية لله، وهذه إنما تتحقق بالجهاد، وبذل النفس، وتقديم محبته عز وجل على كل من سواه، فكان خلق إبليس سبباً لوجود هذه الأمور
3- حصول الابتلاء: ذلك أن إبليس خُلق ليكون محكَّاً يمتحن به الخلق؛ ليتبين به الخبيث من الطيب؛ فإن الله سبحانه خلق النوع الإنساني من الأرض، وفيها الطيب والخبيث؛ فلا بد أن يظهر فيهم ما هو من مادتهم
4- ظهور آثار أسمائه تعالى ومقتضياتها، ومتعلقاتها: فمن أسمائه: الرافع، الخافض، المعز، المذل، الحكم، العدل
وهذه الأسماء تستدعي متعلقاتٍ يظهر فيها أحكامُها، فكان خلق إبليس سبباً لظهور آثار هذه الأسماء، فلو كان الخلق كلهم مطيعين، ومؤمنين لم تظهر آثار هذه الأسماء.
5- استخراج ما في طبائع البشر من الخير والشر: فالطبيعة البشرية مشتملة على الخير والشر، والطيب والخبيث، وذلك كامن فيها كمون النار في الزناد، فَخُلق الشيطان مستخرجاً لما في طبائع أهل الشر من القوة إلى الفعل، وأرسلت الرسل تستخرج ما في طبيعة أهل الخير من القوة إلى الفعل؛ فاستخرج أحكم الحاكمين ما في هؤلاء من الخير الكامن فيها؛ ليترتب عليه آثاره، وما في أولئك من الشر؛ ليترتب عليه آثاره وتظهر حكمته في الفريقين، وينفذ حكمه فيهما، ويظهر ما كان معلوماً له، مطابقاً لعلمه السابق
6- ظهور كثير من آيات الله وعجائب صنعه: فلقد حصل بسبب وقوع الكفر والشر من النفوس الكفَّارة الظالمة ظهور كثير من الآيات والعجائب، كآية الطوفان، وآية الريح، وآية إهلاك ثمود وقوم لوط، وآية انقلاب النار على إبراهيم برداً وسلاماً، والآيات التي أجراها الله على يد موسى، وغير ذلك من الآيات؛ فلولا تقدير كفر الكافرين وجحد الجاحدين لما ظهرت هذه الآيات الباهرة التي يتحدث بها الناس جيلاً بعد جيل إلى الأبد.
أما كونه سبحانه وتعالى أنظر إبليس إلى يوم القيامة فليس ذلك إكراماً له بل إهانة له ليزداد إثماً، فتعظم عقوبته، ويتضاعف عذابه، إضافة إلى ذلك فالله جعله محكَّاً ليميز به الخبيث من الطيب كما سبق وما دام أن الخلق مستمر إلى يوم القيامة فإن هذا يقتضي بقاءه ببقاء خلق البشر، والله أعلم
المطلب الثاني:
خلق المصائب والآلام والحكمة من ذلك:
وكذلك خلقُ الآلام، والمصائب فيه من الحكم ما لا يحيط بعلمه إلا الله عز وجل تلك الحكم التي تنطق بفضل الله، وعدله، ورحمته.
والشرع والقدر أعدلا شاهد بذلك؛ فكم في طلوع الشمس من ألم لمسافر وحاضر، وكم في نزول الغيث والثلوج من أذى كما سماه الله بقوله:(إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ ) (4)
وكم في هذا الحر والبرد والرياح من أذى موجب لأنواع من الآلام لصنوف الحيوانات.
وأعظم لذات الدنيا لذة الأكل والشرب والنكاح واللباس والرياسة، ومعظم آلام أهل الأرض أو كلها ناشئة عنها، ومتولدة منها.
بل الكمالات الإنسانية لا تنال إلا بالآلام والمشاق كالعلم، والشجاعة، والزهد، والعفة، والحلم، والمروءة، والصبر، والإحسان ..
لولا المشقة ساد الناس كلهم / الجود يُفْقرُ والإقدام قتَّالُ
وإذا كانت الآلام أسباباً لِلَذَّاتٍ أعظم منها وأدوم ـ كان العقل يقضي باحتمالها.
ولهذا قالت العقلاء قاطبة: إن النعيم لا يدرك بالنعيم، وإن الراحة لا تنال بالراحة، وإن مَنْ آثر اللذات فاتته اللذات؛ فهذه الآلام والأمراض والمشاق من أعظم النعم؛ إذ هي أسباب النِّعم.
وما ينال الحيوانات غير المكلفة منها فمغمورٌ جداً بالنسبة إلى مصالحها ومنافعها كما ينالها من حر الصيف، وبرد الشتاء، وحبس المطر والثلج، وألم الحمل والولادة، والسعي في طلب أقواتها وغير ذلك.
ولكن لذاتها أضعافُ أضعافِ آلامها، وما ينالها من المنافع والخيرات أضعاف ما ينالها من الشرور والآلام؛ فسُنَّتُه في خلقه وأمره هي التي أوجبها كمالُ علمه وحكمته وعزته.
ولو اجتمعـت عقول العقلاء كلهم علـى أن يقترحوا أحسن منها لعجزوا عن ذلك، وقيل لكلٍّ منهم: ارجع بصر العقل فهل ترى من خلل؟
(ثُمَّ ارْجِع الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئاً وَهُوَ حَسِيرٌ) (5)
فتبارك الذي من كمال حكمته وقدرته أن أخرج الأضداد من أضدادها، والأشياء من خلافها؛ فأخرج الحي من الميت، والميت من الحي، والرطب من اليابس، واليابس من الرطب؛ فكذلك أنشأ اللذاتِ من الآلامِ، والآلامَ من اللذات؛ فأعظم اللذاتِ ثمراتُ الآلام ونتائجها، وأعظم الآلامِ ثمراتُ اللذات ونتائجها.
وبعدُ فاللذةُ والسرورُ، والخيرُ والنعمُ، والعافيةُ والصحةُ والرحمةُ في هذه الدار المملوءة بالمحن والبلاء ـ أكثرُ من أضدادها بأضعافٍ مضاعفة؛ فأين آلام الحيوان من لذته؟ وأين سقمه من صحته؟ وأين جوعه وعطشه من شبعه وريِّه وتعبه من راحته؟! .
هذا وفي الآلام والمصائب حكم عظيمة غير ما ذُكِرَ، وفيما يلي ذكرٌ لبعضها على سبيل الإيجاز؛ إذ المقام لا يتسع للتفصيل:
1- استخراج عبودية الضراء وهي الصبر: قال تعالى : (وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ) (6)
فالابتلاء بالسراء والخير يحتاج إلى شكر، والابتلاء بالضراء والشر يحتاج إلى صبر.
وهذا لا يتم إلا بأن يقّلِّبَ الله الأحوال على العبد حتى يتبين صدق عبوديته لله تعالى .
2- طهارة القلب، والخلاص من الخصال القبيحة: ذلك أن الصحة قد تدعو إلى الأشر، والبطر، والإعجاب بالنفس، لما يتمتع به المرء من نشاط، وقوة، وهدوء بال، ونعيم عيش.
فإذا قُيِّد بالبلاء والمرض انكسرت نفسه، ورق قلبه، وتطهر من أدران الأخلاق الذميمة، والخصال القبيحة من كبر، وخيلاء، وعجب، وحسد، ونحوها، وحلَّ محلَّها الخضوعُ لله، والانكسار بين يديه، والتواضع لخلق الله، وترك الترفع عليهم.
قال المنبجي: وليعلم أهل المصائب أنه لولا محن الدنيا ومصائبها لأصاب العبد من أدواء الكبر، والعجب، والفرعنة، وقسوة القلب ما هو سبب هلاكه عاجلاً وآجلاً؛ فمن رحمة أرحم الراحمين أن يتفقده في الأحيان بأنواع من أدوية المصائب؛ تكون حمية له من هذه الأدواء، وحفظاً لصحة عبوديته، واستفراغاً للمواد الفاسدة، الرديئة، المهلكة؛ فسبحان من يرحم ببلائه، ويبتلي بنعمائه، كما قيل:
قد ينعم الله بالبلوى، وإن عظمت / ويبتلي الله بعض القوم بالنعم
فلولا أنه سبحانه وتعالى يداوي عباده بأدوية المحن والابتلاء لطغوا، وبغوا، وعتوا، وتجبروا في الأرض، وعاثوا فيها بالفساد؛ فإن من شيم النفوس إذا حصل لها أمر، ونهي، وصحة، وفراغ، وكلمة نافذة من غير زاجر شرعي يزجرها تمردت، وسعت في الأرض فساداً، مع علمهم بما فعل بمن قبلهم، فكيف لو حصل لهم مع ذلك إهمال؟
ولكن الله سبحانه وتعالى إذا أراد بعبده خيراً سقاه دواء الابتلاء والامتحان على قدر حاله، يستفرغ منه الأدوية المهلكة، حتى إذا هذبه، ونقاه، وصفَّاه أهَّلَه لأشرف مراتب الدنيا، وهي عبوديته، ورقاه أرفع ثواب الآخرة، وهي رؤيته+
3- تقوية المؤمن: ذلك أن في المصائب تدريباً للمؤمن، وامتحاناً لصبره، وتقوية لإيمانه.
4- النظر إلى قهر الربوبية وذل العبودية: فإنه ليس لأحد مفر عن أمر الله، وقضائه، ولا محيد عن حكمه النافذ وابتلائه؛ فنحن عبيد الله، يتصرف فينا كما يشاؤه ويريده، ونحن إليه راجعون في جميع أمورنا، وإليه المصير يجمعنا لنشورنا.
5- حصول الإخلاص في الدعاء، وصدق الإنابة في التوبة: ذلك أن المصائب تُشعر الإنسان بضعفه، وافتقاره الذاتي إلى ربه، فيبعثه ذلك إلى إخلاص الدعاء له، وشدة التضرُّع والاضطرار إليه، وصدق الإنابة في التوبة والرجوع إليه.
ولولا هذه النوازل لم يُرَ على باب اللجأ والمسكنة؛ فالله عز وجل علم من الخلق اشتغالهم عنه، فابتلاهم من خلال النعم بعوارض تدفعهم إلى بابه يستغيثون به؛ فهذا من النعم في طي البلاء، وإنما البلاء المحض ما يشغلك عن ربك.
6- إيقاظ المبتلى من غفلته: فكم من مبتلى بفقد العافية حصلت له توبة شافية، وكم من مبتلى بفقد ماله انقطع إلى الله بحسن حاله، وكم من غافل عن نفسه، معرضٍ عن ربه أصابه بلاء فأيقظه من رقاده، ونبهه من غفلته، وبعثه لتفقد حاله مع ربه.
7- معرفة قدر العافية: لأن الشيء لا يعرف إلا بضده، فيحصل بذلك الشكرُ الموجب للمزيد من النعم؛ لأن ما مَنَّ الله به من العافية أتم وأنعم، وأكثر وأعظم مما ابتلى وأسقم، ثم إن حصول العافية والنعمة بعد ألم ومشقة أعظم قدراً عند الإنسان.
8- أن من الآلام ما قد يكون سبباً للصحة: فقد يصاب المرء بمرض ويكون سبباً للشفاء من مرض آخر، وقد يبتلى ببلية فيذهب لعلاجها فيكتشف أن به داءً عضالاً لم يكتشف إلا بسبب هذا المرض الطارئ، قال أبو الطيب المتنبي:
لعلَّ عَتْبَك محمودٌ عواقِبُه / وربما صحت الأبدان بالعلل
وهذا شأن أكبر أمراض البدن؛ فهذه الحمى فيها من المنافع للأبدان ما لا يعلمه إلا الله، وفيها من إذابة الفضلات، وإنضاج المواد الفَجَّة وإخراجها ما لا يصل إليه دواءٌ غيرها.
وكثير من الأمراض إذا عرض لصاحبها الحمى استبشر بها الطبيب.
9- حصول رحمة أهل البلاء: فالذي يبتلى بأمر ما يجد في نفسه رحمة لأهل البلاء، وهذه الرحمة موجبة لرحمة الله وجزيل العطاء؛ فمن رَحِمَ من في الأرض رَحِمَهُ من في السماء.
10- حصول الصلاة من الله والرحمة والهداية: قال تعالى: (وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنْ الأَمْوَالِ وَالأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرْ الصَّابِرِينَ، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، أُوْلَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُهْتَدُونَ) (7)
11- حصول الأجر، وكتابة الحسنات وحط الخطيئات: ما من شيء يصيب المؤمن، حتى الشوكةِ تصيبه، إلا كتب الله له بها حسنة، أو حُطت عنه بها خطيئة
بل إن الأجر والثواب لا يختص به المبتلي فحسب، بل يتعداه إلى غيره؛ فالطبيب المسلم إذا عالج المريض واحتسب الأجر كتب له الأجر بإذن الله ؛ فمن نفَّس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفَّس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة.
وكذلك الذي يزور المريض المبتلى يكتب له الأجر، وكذلك من يقوم على رعايته.
12- العلم بحقارة الدنيا وهوانها: فأدنى مصيبة تصيب الإنسان تعكر صفوه، وتنغص حياته، وتنسيه ملاذَّه، والكَيِّسُ الفَطِنُ لا يغتر بالدنيا، بل يجعلها مزرعة للآخرة.
13- أن اختيار الله للعبد خير من اختيار العبد لنفسه: وهذا سر بديع، يحسن بالعبد أن يتفطن له؛ ذلك أن الله عز وجل أرحم الراحمين، وأحكم الحاكمين؛ فهو أعلم بمصالح عباده منهم، وهو أرحم بهم من أنفسهم ووالديهم.
وإذا أنزل بهم ما يكرهون كان خيراً لهم من ألا ينزل بهم؛ نظراً منه لهم، وإحساناً إليهم، ولطفاً بهم.
ولو مكنوا من الاختيار لأنفسهم لعجزوا عن القيام بمصالحهم، لكنه عزوجل تولى تدبير أمورهم بموجب علمه، وعدله، وحكمته، ورحمته أحبوا أم كرهوا.
14- أن الإنسان لا يعلم عاقبة أمره: فربما طلب ما لا تحمد عقباه، وربما كره ما ينفعه، والله عز وجل أعلم بعاقبة الأمر.
ولكن لجهل العبد وظلمه لا يعد العطاء والنعمة والعافية إلا ما التذ به في العاجل، وكان ملائماً لطبعه.
ولو رزق من المعرفة حظَّاً وافراً لعدَّ المنع نعمة، والبلاء رحمة، وتلذذ بالبلاء أكثر من لذته بالعافية، وتلذذ بالفقر أكثر من لذته بالغنى، وكان في حال القلة أعظم شكراً من حال الكثرة+
15- الدخول في زمرة المحبوبين لله عز وجل : فالمبتلون من المؤمنين يدخلون في زمرة المحبوبين المُشَرَّفين بمحبة رب العالمين؛ فهو سبحانه إذا أحب قوماً ابتلاهم، وقد جاء في السنة ما يشير إلى أن الابتلاء دليل محبة الله للعبد؛ حيث قال النبي صلی الله عليه وآله وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط.
16- أن المكروه قد يأتي بالمحبوب والعكس: فإذا صحت معرفة العبد بربه علم يقيناً أن المكروهات التي تصيبه، والمحن التي تنزل به أنها تحمل في طياتها ضروباً من المصالح والمنافع لا يحصيها علمه، ولا تحيط بها فكرته.
بل إن مصلحة العبد فيما يكره أعظم منها فيما يحب؛ فعامة مصالح النفوس في مكروهاتها، كما أن عامَّة مضارها وأسباب هلكتها في محبوباتها، قال تعالى: (فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً) (8)
وقال: (وَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) (9)
فإذا علم العبد أن المكروه قد يأتي بالمحبوب، وأن المحبوب قد يأتي بالمكروه لم يأمن أن توافيه المضرة من جانب المسرة، ولم ييأس أن تأتيه المسرة من جانب المضرة
إلى غير ذلك من الحكم التي قد يعلمها بعض الناس وقد لا يعلمها.
ومن هنا يتضح لنا أنه لا تنافي بين إرادة الله لأمر من الأمور مع بغضه له؛ لما له عز وجل من الحكم العظيمة الباهرة.
هذا وسيأتي مزيد بيان لهذه المسألة في المبحث الآتي عند الحديث عن الحكمة من خلق المعاصي وتقديرها، وعند الحديث عن مسألة الهداية والإضلال.
المصادر :
1- سورة الكهف:79.
2- سورة الكهف: 82.
3- سورة الشعراء: 80.
4- سورة النساء: 102.
5- سورة الملك:4
6- سورة الأنبياء: 35.
7- سورة البقرة: 155-157.
8- سورة النساء: 19.
9- سورة البقرة: 216.
أحدهما: قول نفاة الحكمة، وهو قول الأشاعرة ومن وافقهم ممن يرى أن الله عز وجل قدر المقادير، وشرع الشرائع لغير علة، أو حكمة، بل فعل ذلك لمحض المشيئة، وصرف الإرادة.
الثاني: قول الجمهور الذين يثبتون الحكمة، وأنَّ لله في كل ما يقضيه حكمةً ورحمة.
وهذه الحكمة تتضمن شيئين:
أحدهما: حكمة تعود إليه تعالى يحبها ويرضاها.
والثاني: حكمة تعود إلى عباده، فهي نعمة عليهم يفرحون، ويلتذون بها.
وهذا يكون في المأمورات، والمخلوقات
المطلب الأول: نسبة الشر إلى الله تعالى وحكم ذلك:
إذا سأل سائل فقال:
نحن نؤمن بالقدر خيره وشره من الله، فهل تصح نسبة الشر إلى الله تعالى ؟
وهل يقع في أفعاله شر؟
فالجواب: أن يُقال: إن الله سبحانه وتعالى منزَّه عن الشر، ولا يفعل إلا الخير، والقدر من حيث نسبته إلى الله لا شر فيه بوجه من الوجوه؛ فإنه علم الله، وكتابتُه، ومشيئته، وخلقُه، وذلك خير محض، وكمال من كل وجه، فالشر ليس إلى الرب بوجه من الوجوه، لا في ذاته، ولا في أسمائه ولا صفاته، ولا في أفعاله.
ولو فَعَلَ الشر سبحانه لاشتُق له منه اسم، ولم تكن أسماؤه كلها حسنى، ولعاد إليه من الشر حكمٌ تعالى وتقدس .
وإنما الشر يدخل في مخلوقاته، ومفعولاته، فالشر في المقضي، لا في القضاء، ويكون شرَّاً بالنسبة إلى محل، وخيراً بالنسبة إلى محل آخر، وقد يكون خيراً بالنسبة إلى المحل القائم به من وجه، كما هو شر من وجه آخر، بل هو الغالب، وهذا كالقصاص، وإقامة الحدود، وقتل الكفار؛ فإنه شرٌ بالنسبة إليهم لا من كل وجه، بل من وجه دون وجه، وخير بالنسبة إلى غيرهم لما فيه من مصلحة الزجر، والنكال، ودفع الناس بعضهم ببعض.
وكذلك الأمراض وإن كانت شروراً من وجه فهي خيرٌ من وجوهٍ عديدة.
والحاصل أن الشر لا يُنسب إلى الله تعالى ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن النبي " كان يثني على ربه بتنزيهه عن الشر بدعاء الاستفتاح في قوله: لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت
قال الإمام الصابوني في معنى هذا الحديث:ومعناه والله أعلم والشر ليس مما يُضاف إلى الله إفراداً أو قصداً حتى يُقال: يا خالق الشر، ويا مقدر الشر وإن كان الخالق والمقدر لهما جميعاً؛ لذلك أضاف الخضر عليه السلام إرادة العيب إلى نفسه فقال فيما أخبر الله عنه في قوله:
(أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا) (1)
ولمَّا ذكر الخير والبر والرحمة أضاف إرادتها إلى الله عز وجل فقال:
(فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ) (2)
ولذلك قال مخبراً عن إبراهيم عليه السلام أنه قال:
(وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ) (3)
فأضاف المرض إلى نفسه، والشفاء إلى ربه، وإن كان الجميع منه
وخلقُهُ، وفعلُه، وقضاؤه، وقدره خيرٌ كله؛ ولهذا تنزَّه سبحانه عن الظلم، الذي حقيقته وضع الشيء في غير موضعه، فلا يضع الأشياء إلا في مواضعها اللائقة بها، وذلك خير كله، والشر وضع الشيء في غير محله، فإذا وُضِع في محله لم يكن شرَّاً، فعُلم أن الشر ليس إليه، وأسماؤه الحسنى تشهد بذلك
فأسماؤه الحسنى تمنع نسبة الشر، والسوء، والظلم إليه، مع أنه سبحانه الخالق لكل شيء؛ فهو الخالق للعباد، وأفعالهم، وحركاتهم، وأقوالهم، والعبد إذا فعل القبيحَ المنهيَّ عنه، كان قد فعل الشرَّ والسوءَ.
والربُّ سبحانه هو الذي جعله فاعلاً لذلك، وهذا الجَعْل منه عدلٌ وحكمةٌ، وصوابٌ، فَجَعْلُهُ فاعلاً خيرٌ، والمفعولُ شرٌّ قبيح؛ فهو سبحانه بهذا الجعل قد وضع الشيء في موضعه؛ لما له في ذلك من الحكمة البالغة التي يحمد عليها، فهو خير وحكمة، ومصلحة، وإن كان وقوعه من العبد عيباً، ونقصاً، وشرَّاً
والحاصل أن الله تعالى لا يُنسب إليه الشر؛ لأنه إن أريد بالشر وضع الشيء في غير موضعه فهو الظلم، ومقابله العدل، والله منزَّه عن الظلم.
وإن أُريد به الأذى اللاحق بالمحل بسبب ذنب ارتكبه فإيجاد الله للعقوبة على ذنب لا يُعد شرَّاً له؛ بل ذلك عدلٌ منه تعالى .
وإن أُريد به عدم الخير، وأسبابه الموصلة إليه فالعَدَمُ ليس فعلاً حتى ينسب إلى الله، وليس للعبد على الله أن يوفقه، فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، ومنع الفضل ليس بظلم ولا شر
ثم إن على العبد إذا عرف ما يضره وينفعه أن يَذلَّ لله عز وجل حتى يعينه على فعل ما ينفعه، ولا يقول: أنا لا أفعل حتى يخلق الله فيَّ الفعل، كما أنه لو هجم عليه عدو أو سبع فإنه يهرب ويفر ولا يقول: سأنتظر حتى يخلق الله فيَّ الهرب
ومن هنا يتبين لنا أن الشر لا ينسب إلى الله عز وجل .
وهذا ما سيتضح في المباحث التالية.
الحكمة من إرادة الله لما يحبه:
إذا قيل: كيف يريد الله أمراً، وفي الوقت نفسه لا يرضاه ولا يحبه؟ وكيف يجمع بين إرادته له وبغضه وكراهته؟قيل: إن المراد نوعان: مراد لنفسه، ومراد لغيره، فالمراد لنفسه مطلوب محبوب لذاته وما فيه من الخير؛ فهو مراد إرادة الغايات والمقاصد.
والمراد لغيره قد لا يكون مقصوداً لما يريد، ولا فيه مصلحة بالنظر إلى ذاته وإن كان وسيلة إلى مقصوده، ومراده فهو مكروه له من حيث نفسه وذاته، مراد له من حيث قضاؤه، وإيصاله إلى مراده؛ فيجتمع الأمران: بغضه، وإرادته، ولا يتنافيان، فيبغض من وجه، ويحب من وجه آخر.
وهذا أمر معلوم عند الخلق؛ فهذا الدواء الكريه الطعم والرائحة إذا علم الإنسان أن فيه شفاءَه أبغضه من وجه، وأحبه من وجه آخر؛ فيكرهه من جهة تألمه به، ويحبه من جهة إفضائه إلى ما يحب.
وقل مثل ذلك في العضو المتآكل إذا عَلِم أن في قطعه بقاءً لجسده، وكقطع المسافة الشاقة إذا عَلِم أنها توصل إلى مراده، ومحبوبه، كالذي يقطع الفيافي، والمفاوز، والقفار، قاصداً البيت العتيق.
ومن هنا يتبين لنا أن الشيء يجتمع فيه الأمران: بغض من وجه، وحب من وجه آخر، ولا يتنافيان، هذا في شأن المخلوق، فكيف بالخالق الذي لا تخفى عليه خافية، الذي له الحكمة البالغة؟ فهو سبحانه يكره الشيء، ولا يتنافى ذلك مع إرادته له لأجل غيره، وكونه سبباً إلى أمر محبوب .
الحكمة من خلق إبليس، وخلق المصائب والآلام
المطلب الأول:خلق إبليس والحكمة من ذلك:
الله عز وجل خلق إبليس الذي هو مادة الفساد التي تمد كل فساد في هذه الدنيا، في الأديان، والاعتقادات، والشهوات، والشبهات، وهو سبب لشقاوة العباد، وعَمَلِهم ما يغضب الله عز وجل وهو مع ذلك كله وسيلة إلى محابَّ كثيرةٍ، وحكم عظيمة.
إذا تقرر ذلك فهذه بعض الحكم التي تلمسها العلماء من خلق إبليس:
1- أن يَظهر للعباد قدرةُ الرب تعالى على خلق المتضادات والمتقابلات: فخلق هذه الذات إبليس التي هي أخبث الذوات، وهي سبب كل شر، وخَلَق في مقابلها ذات جبريل التي هي من أشرف الذوات وأزكاها، والتي هي مادة كل خير، فتبارك من خلق هذا وهذا، كما ظهرت قدرته في خلق الليل والنهار، والحر والبرد، والماء والنار، والداء والدواء، والموت والحياة، والحسن والقبيح، فالضد يظهر حسنه الضد، وهذا أدلُّ دليل على كمال قدرته، وعزته، وملكه، وسلطانه؛ فإنه خلق هذه المتضادات، وقابل بعضها ببعض، وسلط بعضها على بعض، وجعلها محل تصرفه، وتدبيره، وحكمته، فخلوُّ الوجود عن بعضها بالكلية تعطيل لحكمته، وكمال تصرفه، وتدبير مملكته
2- أن يُكَمِّلَ الله لأوليائه مراتب العبودية: وذلك بمجاهدة إبليس وحزبه، وإغاظته بالطاعة لله، والاستعاذة بالله منه، واللجوء إلى الله أن يعيذهم منه ومن كيده، فيترتب لهم على ذلك من المصالح الدنيوية، والأخروية ما لا يحصل بدونه.
ثم إن المحبة، والإنابة، والتوكل، والصبر، والرضا، ونحوها أحب أنواع العبودية لله، وهذه إنما تتحقق بالجهاد، وبذل النفس، وتقديم محبته عز وجل على كل من سواه، فكان خلق إبليس سبباً لوجود هذه الأمور
3- حصول الابتلاء: ذلك أن إبليس خُلق ليكون محكَّاً يمتحن به الخلق؛ ليتبين به الخبيث من الطيب؛ فإن الله سبحانه خلق النوع الإنساني من الأرض، وفيها الطيب والخبيث؛ فلا بد أن يظهر فيهم ما هو من مادتهم
4- ظهور آثار أسمائه تعالى ومقتضياتها، ومتعلقاتها: فمن أسمائه: الرافع، الخافض، المعز، المذل، الحكم، العدل
وهذه الأسماء تستدعي متعلقاتٍ يظهر فيها أحكامُها، فكان خلق إبليس سبباً لظهور آثار هذه الأسماء، فلو كان الخلق كلهم مطيعين، ومؤمنين لم تظهر آثار هذه الأسماء.
5- استخراج ما في طبائع البشر من الخير والشر: فالطبيعة البشرية مشتملة على الخير والشر، والطيب والخبيث، وذلك كامن فيها كمون النار في الزناد، فَخُلق الشيطان مستخرجاً لما في طبائع أهل الشر من القوة إلى الفعل، وأرسلت الرسل تستخرج ما في طبيعة أهل الخير من القوة إلى الفعل؛ فاستخرج أحكم الحاكمين ما في هؤلاء من الخير الكامن فيها؛ ليترتب عليه آثاره، وما في أولئك من الشر؛ ليترتب عليه آثاره وتظهر حكمته في الفريقين، وينفذ حكمه فيهما، ويظهر ما كان معلوماً له، مطابقاً لعلمه السابق
6- ظهور كثير من آيات الله وعجائب صنعه: فلقد حصل بسبب وقوع الكفر والشر من النفوس الكفَّارة الظالمة ظهور كثير من الآيات والعجائب، كآية الطوفان، وآية الريح، وآية إهلاك ثمود وقوم لوط، وآية انقلاب النار على إبراهيم برداً وسلاماً، والآيات التي أجراها الله على يد موسى، وغير ذلك من الآيات؛ فلولا تقدير كفر الكافرين وجحد الجاحدين لما ظهرت هذه الآيات الباهرة التي يتحدث بها الناس جيلاً بعد جيل إلى الأبد.
أما كونه سبحانه وتعالى أنظر إبليس إلى يوم القيامة فليس ذلك إكراماً له بل إهانة له ليزداد إثماً، فتعظم عقوبته، ويتضاعف عذابه، إضافة إلى ذلك فالله جعله محكَّاً ليميز به الخبيث من الطيب كما سبق وما دام أن الخلق مستمر إلى يوم القيامة فإن هذا يقتضي بقاءه ببقاء خلق البشر، والله أعلم
المطلب الثاني:
خلق المصائب والآلام والحكمة من ذلك:
وكذلك خلقُ الآلام، والمصائب فيه من الحكم ما لا يحيط بعلمه إلا الله عز وجل تلك الحكم التي تنطق بفضل الله، وعدله، ورحمته.
والشرع والقدر أعدلا شاهد بذلك؛ فكم في طلوع الشمس من ألم لمسافر وحاضر، وكم في نزول الغيث والثلوج من أذى كما سماه الله بقوله:(إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ ) (4)
وكم في هذا الحر والبرد والرياح من أذى موجب لأنواع من الآلام لصنوف الحيوانات.
وأعظم لذات الدنيا لذة الأكل والشرب والنكاح واللباس والرياسة، ومعظم آلام أهل الأرض أو كلها ناشئة عنها، ومتولدة منها.
بل الكمالات الإنسانية لا تنال إلا بالآلام والمشاق كالعلم، والشجاعة، والزهد، والعفة، والحلم، والمروءة، والصبر، والإحسان ..
لولا المشقة ساد الناس كلهم / الجود يُفْقرُ والإقدام قتَّالُ
وإذا كانت الآلام أسباباً لِلَذَّاتٍ أعظم منها وأدوم ـ كان العقل يقضي باحتمالها.
ولهذا قالت العقلاء قاطبة: إن النعيم لا يدرك بالنعيم، وإن الراحة لا تنال بالراحة، وإن مَنْ آثر اللذات فاتته اللذات؛ فهذه الآلام والأمراض والمشاق من أعظم النعم؛ إذ هي أسباب النِّعم.
وما ينال الحيوانات غير المكلفة منها فمغمورٌ جداً بالنسبة إلى مصالحها ومنافعها كما ينالها من حر الصيف، وبرد الشتاء، وحبس المطر والثلج، وألم الحمل والولادة، والسعي في طلب أقواتها وغير ذلك.
ولكن لذاتها أضعافُ أضعافِ آلامها، وما ينالها من المنافع والخيرات أضعاف ما ينالها من الشرور والآلام؛ فسُنَّتُه في خلقه وأمره هي التي أوجبها كمالُ علمه وحكمته وعزته.
ولو اجتمعـت عقول العقلاء كلهم علـى أن يقترحوا أحسن منها لعجزوا عن ذلك، وقيل لكلٍّ منهم: ارجع بصر العقل فهل ترى من خلل؟
(ثُمَّ ارْجِع الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئاً وَهُوَ حَسِيرٌ) (5)
فتبارك الذي من كمال حكمته وقدرته أن أخرج الأضداد من أضدادها، والأشياء من خلافها؛ فأخرج الحي من الميت، والميت من الحي، والرطب من اليابس، واليابس من الرطب؛ فكذلك أنشأ اللذاتِ من الآلامِ، والآلامَ من اللذات؛ فأعظم اللذاتِ ثمراتُ الآلام ونتائجها، وأعظم الآلامِ ثمراتُ اللذات ونتائجها.
وبعدُ فاللذةُ والسرورُ، والخيرُ والنعمُ، والعافيةُ والصحةُ والرحمةُ في هذه الدار المملوءة بالمحن والبلاء ـ أكثرُ من أضدادها بأضعافٍ مضاعفة؛ فأين آلام الحيوان من لذته؟ وأين سقمه من صحته؟ وأين جوعه وعطشه من شبعه وريِّه وتعبه من راحته؟! .
هذا وفي الآلام والمصائب حكم عظيمة غير ما ذُكِرَ، وفيما يلي ذكرٌ لبعضها على سبيل الإيجاز؛ إذ المقام لا يتسع للتفصيل:
1- استخراج عبودية الضراء وهي الصبر: قال تعالى : (وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ) (6)
فالابتلاء بالسراء والخير يحتاج إلى شكر، والابتلاء بالضراء والشر يحتاج إلى صبر.
وهذا لا يتم إلا بأن يقّلِّبَ الله الأحوال على العبد حتى يتبين صدق عبوديته لله تعالى .
2- طهارة القلب، والخلاص من الخصال القبيحة: ذلك أن الصحة قد تدعو إلى الأشر، والبطر، والإعجاب بالنفس، لما يتمتع به المرء من نشاط، وقوة، وهدوء بال، ونعيم عيش.
فإذا قُيِّد بالبلاء والمرض انكسرت نفسه، ورق قلبه، وتطهر من أدران الأخلاق الذميمة، والخصال القبيحة من كبر، وخيلاء، وعجب، وحسد، ونحوها، وحلَّ محلَّها الخضوعُ لله، والانكسار بين يديه، والتواضع لخلق الله، وترك الترفع عليهم.
قال المنبجي: وليعلم أهل المصائب أنه لولا محن الدنيا ومصائبها لأصاب العبد من أدواء الكبر، والعجب، والفرعنة، وقسوة القلب ما هو سبب هلاكه عاجلاً وآجلاً؛ فمن رحمة أرحم الراحمين أن يتفقده في الأحيان بأنواع من أدوية المصائب؛ تكون حمية له من هذه الأدواء، وحفظاً لصحة عبوديته، واستفراغاً للمواد الفاسدة، الرديئة، المهلكة؛ فسبحان من يرحم ببلائه، ويبتلي بنعمائه، كما قيل:
قد ينعم الله بالبلوى، وإن عظمت / ويبتلي الله بعض القوم بالنعم
فلولا أنه سبحانه وتعالى يداوي عباده بأدوية المحن والابتلاء لطغوا، وبغوا، وعتوا، وتجبروا في الأرض، وعاثوا فيها بالفساد؛ فإن من شيم النفوس إذا حصل لها أمر، ونهي، وصحة، وفراغ، وكلمة نافذة من غير زاجر شرعي يزجرها تمردت، وسعت في الأرض فساداً، مع علمهم بما فعل بمن قبلهم، فكيف لو حصل لهم مع ذلك إهمال؟
ولكن الله سبحانه وتعالى إذا أراد بعبده خيراً سقاه دواء الابتلاء والامتحان على قدر حاله، يستفرغ منه الأدوية المهلكة، حتى إذا هذبه، ونقاه، وصفَّاه أهَّلَه لأشرف مراتب الدنيا، وهي عبوديته، ورقاه أرفع ثواب الآخرة، وهي رؤيته+
3- تقوية المؤمن: ذلك أن في المصائب تدريباً للمؤمن، وامتحاناً لصبره، وتقوية لإيمانه.
4- النظر إلى قهر الربوبية وذل العبودية: فإنه ليس لأحد مفر عن أمر الله، وقضائه، ولا محيد عن حكمه النافذ وابتلائه؛ فنحن عبيد الله، يتصرف فينا كما يشاؤه ويريده، ونحن إليه راجعون في جميع أمورنا، وإليه المصير يجمعنا لنشورنا.
5- حصول الإخلاص في الدعاء، وصدق الإنابة في التوبة: ذلك أن المصائب تُشعر الإنسان بضعفه، وافتقاره الذاتي إلى ربه، فيبعثه ذلك إلى إخلاص الدعاء له، وشدة التضرُّع والاضطرار إليه، وصدق الإنابة في التوبة والرجوع إليه.
ولولا هذه النوازل لم يُرَ على باب اللجأ والمسكنة؛ فالله عز وجل علم من الخلق اشتغالهم عنه، فابتلاهم من خلال النعم بعوارض تدفعهم إلى بابه يستغيثون به؛ فهذا من النعم في طي البلاء، وإنما البلاء المحض ما يشغلك عن ربك.
6- إيقاظ المبتلى من غفلته: فكم من مبتلى بفقد العافية حصلت له توبة شافية، وكم من مبتلى بفقد ماله انقطع إلى الله بحسن حاله، وكم من غافل عن نفسه، معرضٍ عن ربه أصابه بلاء فأيقظه من رقاده، ونبهه من غفلته، وبعثه لتفقد حاله مع ربه.
7- معرفة قدر العافية: لأن الشيء لا يعرف إلا بضده، فيحصل بذلك الشكرُ الموجب للمزيد من النعم؛ لأن ما مَنَّ الله به من العافية أتم وأنعم، وأكثر وأعظم مما ابتلى وأسقم، ثم إن حصول العافية والنعمة بعد ألم ومشقة أعظم قدراً عند الإنسان.
8- أن من الآلام ما قد يكون سبباً للصحة: فقد يصاب المرء بمرض ويكون سبباً للشفاء من مرض آخر، وقد يبتلى ببلية فيذهب لعلاجها فيكتشف أن به داءً عضالاً لم يكتشف إلا بسبب هذا المرض الطارئ، قال أبو الطيب المتنبي:
لعلَّ عَتْبَك محمودٌ عواقِبُه / وربما صحت الأبدان بالعلل
وهذا شأن أكبر أمراض البدن؛ فهذه الحمى فيها من المنافع للأبدان ما لا يعلمه إلا الله، وفيها من إذابة الفضلات، وإنضاج المواد الفَجَّة وإخراجها ما لا يصل إليه دواءٌ غيرها.
وكثير من الأمراض إذا عرض لصاحبها الحمى استبشر بها الطبيب.
9- حصول رحمة أهل البلاء: فالذي يبتلى بأمر ما يجد في نفسه رحمة لأهل البلاء، وهذه الرحمة موجبة لرحمة الله وجزيل العطاء؛ فمن رَحِمَ من في الأرض رَحِمَهُ من في السماء.
10- حصول الصلاة من الله والرحمة والهداية: قال تعالى: (وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنْ الأَمْوَالِ وَالأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرْ الصَّابِرِينَ، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، أُوْلَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُهْتَدُونَ) (7)
11- حصول الأجر، وكتابة الحسنات وحط الخطيئات: ما من شيء يصيب المؤمن، حتى الشوكةِ تصيبه، إلا كتب الله له بها حسنة، أو حُطت عنه بها خطيئة
بل إن الأجر والثواب لا يختص به المبتلي فحسب، بل يتعداه إلى غيره؛ فالطبيب المسلم إذا عالج المريض واحتسب الأجر كتب له الأجر بإذن الله ؛ فمن نفَّس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفَّس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة.
وكذلك الذي يزور المريض المبتلى يكتب له الأجر، وكذلك من يقوم على رعايته.
12- العلم بحقارة الدنيا وهوانها: فأدنى مصيبة تصيب الإنسان تعكر صفوه، وتنغص حياته، وتنسيه ملاذَّه، والكَيِّسُ الفَطِنُ لا يغتر بالدنيا، بل يجعلها مزرعة للآخرة.
13- أن اختيار الله للعبد خير من اختيار العبد لنفسه: وهذا سر بديع، يحسن بالعبد أن يتفطن له؛ ذلك أن الله عز وجل أرحم الراحمين، وأحكم الحاكمين؛ فهو أعلم بمصالح عباده منهم، وهو أرحم بهم من أنفسهم ووالديهم.
وإذا أنزل بهم ما يكرهون كان خيراً لهم من ألا ينزل بهم؛ نظراً منه لهم، وإحساناً إليهم، ولطفاً بهم.
ولو مكنوا من الاختيار لأنفسهم لعجزوا عن القيام بمصالحهم، لكنه عزوجل تولى تدبير أمورهم بموجب علمه، وعدله، وحكمته، ورحمته أحبوا أم كرهوا.
14- أن الإنسان لا يعلم عاقبة أمره: فربما طلب ما لا تحمد عقباه، وربما كره ما ينفعه، والله عز وجل أعلم بعاقبة الأمر.
ولكن لجهل العبد وظلمه لا يعد العطاء والنعمة والعافية إلا ما التذ به في العاجل، وكان ملائماً لطبعه.
ولو رزق من المعرفة حظَّاً وافراً لعدَّ المنع نعمة، والبلاء رحمة، وتلذذ بالبلاء أكثر من لذته بالعافية، وتلذذ بالفقر أكثر من لذته بالغنى، وكان في حال القلة أعظم شكراً من حال الكثرة+
15- الدخول في زمرة المحبوبين لله عز وجل : فالمبتلون من المؤمنين يدخلون في زمرة المحبوبين المُشَرَّفين بمحبة رب العالمين؛ فهو سبحانه إذا أحب قوماً ابتلاهم، وقد جاء في السنة ما يشير إلى أن الابتلاء دليل محبة الله للعبد؛ حيث قال النبي صلی الله عليه وآله وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط.
16- أن المكروه قد يأتي بالمحبوب والعكس: فإذا صحت معرفة العبد بربه علم يقيناً أن المكروهات التي تصيبه، والمحن التي تنزل به أنها تحمل في طياتها ضروباً من المصالح والمنافع لا يحصيها علمه، ولا تحيط بها فكرته.
بل إن مصلحة العبد فيما يكره أعظم منها فيما يحب؛ فعامة مصالح النفوس في مكروهاتها، كما أن عامَّة مضارها وأسباب هلكتها في محبوباتها، قال تعالى: (فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً) (8)
وقال: (وَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) (9)
فإذا علم العبد أن المكروه قد يأتي بالمحبوب، وأن المحبوب قد يأتي بالمكروه لم يأمن أن توافيه المضرة من جانب المسرة، ولم ييأس أن تأتيه المسرة من جانب المضرة
إلى غير ذلك من الحكم التي قد يعلمها بعض الناس وقد لا يعلمها.
ومن هنا يتضح لنا أنه لا تنافي بين إرادة الله لأمر من الأمور مع بغضه له؛ لما له عز وجل من الحكم العظيمة الباهرة.
هذا وسيأتي مزيد بيان لهذه المسألة في المبحث الآتي عند الحديث عن الحكمة من خلق المعاصي وتقديرها، وعند الحديث عن مسألة الهداية والإضلال.
المصادر :
1- سورة الكهف:79.
2- سورة الكهف: 82.
3- سورة الشعراء: 80.
4- سورة النساء: 102.
5- سورة الملك:4
6- سورة الأنبياء: 35.
7- سورة البقرة: 155-157.
8- سورة النساء: 19.
9- سورة البقرة: 216.
source : راسخون